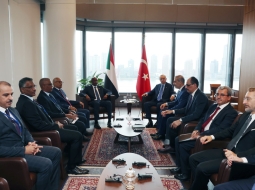جو حمّورة - لبنان الرسالة
"لا تتوهم أن الحياة خارج لبنان أكلة عسل". بهذه الكلمات ودّعني جدّي، ثم طبع قبلة على خدّي وأنهى حديثه: "لا تتأخر بالعودة قبل أن أغادر (إلى السماء)".
يثبت أجدادنا دوماً أنهم على حق، خصوصاً إن كان الأمر يتعلق بالمشاعر. فمن عاصر لبنان الحديث، من ازدهار وحرب وفقر وكرامة، لا شك بأنه يعرف أكثر من شاب يقصد بلداً أجنبياً بهدف الدراسة. مرّت أربعة أشهر على مغادرتي للبنان، ولا تبدو الحياة هنا، في تركيا، "أكلة عسل".
تستقبلك هذه البلاد بأبهى حللها. الشرق والغرب وحضاراتهما يُختصرون بمدينة سُميّت إسطنبول. هنا، كل شيء يلمع. الجدران، الأطباق، المساجد، التُحف... والعيون. حتى البحر الذي يقسم المدينة إلى شطرين فيه شيء من اللمعان. كيف لمدينة تحوي على 15 مليون إنسان أن تنعم ببحر غير ملوث!؟
تتفاجئ وأنت تنظر إلى السواح الأوروبيين بمدى الدهشة الظاهرة على وجوههم. التمعن في أدق تفاصيل الشوارع والمتاحف هواية السائح، خصوصاً من توحي لك مشيته البطيئة أنه في سن التقاعد. الضخامة صفة ملتصقةبكل شيء، وهذه المدينة تكره البساطة. كنائسها ومساجدها أبزر معالمها، وتحتل مساحة كبيرة من وسط المدينة، كما الاهتمام الأكبر من آلات تصوير المارة.
من حيث آتي، من جبل لبنان، تغلب البساطة على بيوت الله.ضخامة الكنائس عندي أقرب إلى الاسراف غير المبرر من أي أمر آخر. البساطة سمة كنيستي وشكلها وناسها، فيما كنائس إسطنبول أقرب إلى متاحف ضخمة وقصور عاجية، حيث يراود زائرها عند دخولها شعور من اثنان: إما الدهشة وإما النفور.
مقارنة كنائس لبنان مع كنائس اسطنبول تبدو مغرية. البساطة سمة الأولى، وشكلها الحجري المربّع يوحي لك بالدقة والعشوائية في آن. أجراسها الصدئة تضفي على روادها الدائمين لمحة من التاريخ والتراث. لم تُبنَ كنيسة في جبل لبنان بقدرة إمبراطورية أو مساهمة صندوق أجنبي، إنما بزنود وتعب فلاحي القرى. هؤلاء هم الكنيسة على جميع الأحوال.
هؤلاء الذين نراهم جالسين في زوايا الكنائس بخشوع، ولا يعيشون ازدواجية بين حياتهم الروحية والعامة هم الكنيسة. هؤلاء الذين يتنافسون بفرح على من "يربّع" الجرس هم الكنيسة. أشتاق إلى هؤلاء، وليس لقاصدي الكنائس للمناسبات الاجتماعية وحب الاختلاط. اشتقت لصوت الجرس "الطبيعي" المصنوع بقوة زنود رجال القرى، وليس لمكبر الصوت الذي يُعيد شريط صوت الجرس كصنم تنقصه حياة.
بعيداً عن التفاصيل.. والبساطة، كنائس إسطنبول تأتي من عالم آخر. يدخل إلى كل واحدة منها بضعة آلاف من الناس يومياً، ولكن لالتقاط الصور. الكنائس في عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الغابرة هي، عملياً، متاحف، بعضها تحوّلت ملكيته رسمياً للدولة، وغيرها أصبح متحفاً بحكم الأمر الواقع وندرة المؤمنين وغياب الرعية وخدّامها.
مجنون ذلك الذي يبحث عن البساطة في إسطنبول. الهندسة، الزخرفة، الذهب واللوحات الرائعة توحي بأنك أمام عرش عثماني أو حاكم روماني سيخرج عليك من وراء المذبح. كيف لكنيسة كانت تحكم المشرق كله من حديقتها الخلفية أن تتحول إلى متحف لالتقاط الصور؟ كيف لرعية ملكت أبهى الكنائس وأجمل المزارات أن تتضائل إلى حد الاختفاء؟
صحيح أن الحكم العثماني كما التركي العلماني اللاحق لم يعاملا، غالباً، أقليات إسطنبول بشكل جيد. إلا أن مصائب مسيحيي هذا الزمن هم "المسيحيون" أنفسهم، وليس أي أحد آخر. الكذب، الدجل، البغض والنميمة أخطر على المسيحيين من أعتى جيوش الأرض. عدم الاهتمام بالشأن العام والمجتمع، و "الترفع" عن العمل السياسي والتنموي أخطر على المسيحيين من شرور أقوى الممالك. اللامبالاة مرضنا القاتل.
في حالة إسطنبول، تفكّكت الروابط العائلية وزاد حب المظاهر وامتلاك الكماليات عندما قلّدت إسطنبول أسلوب استهلاك ونمط المدن الأوروبية، فأغرى التمدّن الناس للابتعاد عن الكنيسة (والجامع). وحياة التمدّن، بدورها، حثت الناس على ترك الأرض والهجرة للبحث عن أحلام الثروة والسعادة. فُقد الإيمان وفُقد حب الوطن، ففرِّغت الكنيسة وهاجرت الرعية. فيما بقيت الكنائس مجرد متاحف أنيقة شاهدة على أناس إستسلموا أمام خطر صنعوه بأيديهم، و"فرّوا" إلى أوروبا دون معركة.
كثرت الكنائس (والمساجد) في هذه المدينة حتى باتت معظمها فارغة. غلبت الضخامة بساطة الإيمان. تم إيلاء الشكل أهمية فاقت المضمون والمعنى. اهتم الأتراك ببيوت الله الفارهة لأسباب تجارية وإيديولوجية وأهملوا أبناءه. غلب التمدّن والاستهلاك على نمط حياة ملايين المدينة، واستسلم الجميع للمال واللذة.هجر الله المدينة وترك لزوارها بيوته.
التمدّن مصيبة العصر، وهو المرض الذي يخلق ازدواجية في حياة الناس. تُبهرك المدينة و "ثقافتها" الرثة بالألوان والأموال. وعلى مبانيها الفارهة تقدّم لك "الخلاص" على شكل لوحة إعلانية: استهلك تعش سعيداً.امتلك لتصبح أهم.اقترض لترضي غرورك. صفّق لتترقى...
لبنان ليس إسطنبول. تختلف الكنائس ويختلف الناس. التمدّن لم يقتل أرواحنا بعد. لا يزال جدّي، وآخرون مثله، ينظرون إلى المدينة بشيء من التوجّس والبُغض. هذه المدن "الغريبة" سرقت أبناءهم في الحرب أو هربتهم عبر موانئها ومطارها، وانتجت كل فساد وظلم في لبنان. كيف لمن يرى فقراء بيروت مرميين على زجاج السيارات للتسوّل، وآخرون نائمون تحت جسورها ألا يكره هذه المدينة؟ كيف يمكن لمن وعدته المدينة بالسعادة والفرح والعمل وأنهته مرمياً ومذلولاً على قارعة طريق ألا يكره زعماءها؟ كيف يمكن لأبناء الجبل والبقاع وأطراف لبنان ألا يكرهوا فساد ومركزية المدينة وأموالهم تذهب لتنميتها فقط؟
جدّي ربى أولاده الثمانية على حب الأرض والكنيسة والقرية، وأحفاده استمروا على العهد. لم نغرق في وحل المدن، ولم نتعلق بقشورها وإعلاناتها المثيرة ووعودها الكاذبة. بقينا أولاد قرى، نعيش فيها أو نزورها مواظبين كل أسبوع. التربية الصالحة غلبت التمدّن وأبقتنا أولاد الأرض والرجاء.
اقترب عيد الميلاد ولا عيد في إسطنبول. زيارة لبنان باتت ضرورة، وجدّي ينتظر أحفاده في زاوية الكنيسة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس