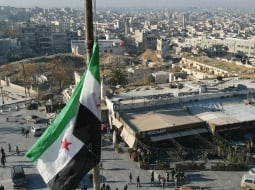سليمان سيفي أوغون - يني شفق
لا تزال عاصفة ترامب تعصف بالعالم. بعض الدول، التي لا يُستهان بعددها، تتعامل مع هذه العاصفة بدهشة على نحو: "إنه مجنون، وما يصدر عنه طبيعي، وسرعان ما تنتهي هذه المرحلة." أما البعض الآخر، فيراها فرصة ذهبية ويقول: "هذه العاصفة هي بالضبط ما أريده، وسأستفيد منها."
وكلا النوعين من التفاعل ينبع من مشاعر وحسابات تدور داخل دائرة فاسدة.
صحيح أن ترامب يبدو في صحة جيدة، لكنه في سن متقدمة جدًا، ولا أحد يعلم ماذا قد يحدث في أي لحظة. وقد يعترض بعض القراء قائلين: "أنت تُشخصن المسألة كثيرًا، فترامب مجرد نتيجة لمسار معيّن. وإذا رحل، فسيأتي غيره، وربما أسوأ منه." وهذا اعتراض في محلّه. وأنا كذلك أؤمن بأن الأشخاص يتشكّلون من خلال سيرورات موضوعية، ويبرزون كنتيجة لها. ويمكنني القول إن الفكرة المحورية لهذا المقال ترتكز على هذه النقطة تحديدًا…
نعم، ما يفعله ترامب من تشتيت للعالم، وما يقوم به ماسك من تصرفات وكأنه يتجول بمنشار بيده، ليس أمرًا جديدًا أو مفاجئًا، بل هو نتيجة لمسارات سابقة. نعم، عهد ترامب سيزول، وستتم تجاوز الأضرار التي ألحقها.
ما يُقلقني ليس مجيء "مجنون" مثل ترامب إلى مقود قيادة العالم، بل استمرار تلك السيرورات التي أوصلته إلى هناك حتى بعد رحيله، وبشكل مستقل عنه.
لا تقلقوا، فلن أطلق شعارات إنشائية مثل: "التاريخ لا يبقى في يد الظالم، والنصر دائمًا في صفّ الحق." لقد أكّدت مرارًا في كتاباتي أنني أنظر إلى التاريخ بنظرة جدلية (ديالكتيكية)، وأدرك جيدًا أن مسارات التشييء (تحويل الإنسان إلى موضوع أو أداة) تسبق عمليات التكوّن الذاتي للفواعل.
وبصورة مبسطة: أُدرك أن أعظم رغبة للعبد الذي يتمرّد على سيده، هي أن يُصبح هو نفسه سيدًا مستبدًا.
(لو كان سبارتاكوس قد أسقط روما، فهل كان سيلغي العبودية؟ أم كان سيلقي بأسياده السابقين في حلبات المصارعة أمام الأسود؟)
أملك من التجربة ما يكفي لأتوقع أن أكثر الطغاة قسوة خرجوا من بين صفوف المظلومين. والثورية، التي أتابعها أحيانًا بعاطفة، أراها في كثير من الأحيان في سذاجة سيسيفوسية. النقطة التي يتجاهلها البعض هي أن "الظلم" يجعل من "المظلومية" موضوعًا، أي أداة بيد الظالم.
وهذا التشييء هو التجربة الوحيدة والمحسوسة لمن يُشيّأ. والتحليلات الأخلاقية، مهما كانت عميقة، تبقى هامشية أمام هذه التجربة الملموسة.
لكن هذا "الهامش" هو ما يصنع الخطاب. وحين يكون الخطاب أخلاقيًا، يتوقع الجميع أن يكون المسار نفسه أخلاقيًا، وهذه سذاجة أخرى.
لكن التجارب المحسوسة تضرب هذا الخطاب كتيارات جارفة من الأعماق، وتآكله تدريجيًا. وفي النهاية، ما يحدد المسار هو هذه التجارب.
فالمسارات التي تحوّل الناس إلى أدوات، هي نفسها التي ترسم، لاحقًا، شكل وتوجّه تحولهم إلى فاعلين.
لنعرض بعض الأمثلة: البؤس الذي عاشته الطبقة العاملة في القرن التاسع عشر انتهى إلى ما يمكن تسميته بـ"البرجزة" (التحول إلى طبقة وسطى).
وهذا التحول لم يكن سوى تحقيق جزئي لرغبة عميقة عند الطبقة العاملة في تقليد نمط حياة أرباب عملهم.
ومن غير المصادفة أن أعنف أشكال الولع بالرأسمالية ظهرت في المجتمعات التي عاشت "ديكتاتورية البروليتاريا"، تلك التي كانت تُسمى يومًا ما مجتمعات اشتراكية.
لقد أصاب ماركس تمامًا عندما حدّد الصراع بين العمل ورأس المال كمحور مركزي لتشكّل العالم الحديث. ويبدو لي أنه لم يصل إلى هذا التحليل من خلال مفكر أخلاقي مثل برودون، بل عبر التقارب مع شخص مثل إنجلز، المتمسّك بإرث التنوير العقلاني.
لكن، كما هو الحال في كل منظومة فكرية، هناك ثقوب سوداء داخلية. ويبدو لي أن ماركس توقّف عمدًا قبل الوصول إلى حافة هذا الثقب.
لأنه لو استمر في تفكيره كما يجب، ومن دون تحريف، لكان مضطرًا لاحقًا لفعل ما قامت به "مدرسة فرانكفورت": إغلاق المتجر بالكامل.
لكنه لم يفعل.
تجاهل أن الرؤية "الموضوعية" التي تبنّاها هي طريق مسدود؛ تجاهل أن العمل نفسه مُشيّأ من قبل رأس المال؛ وأن هذا التشييء يُفقد الطبقة العاملة منذ البداية طاقتها الثورية.
من الأمور التي لفتت انتباهي وأورثتني شعورًا عميقًا باليأس، أمر غريب واحد على وجه الخصوص: اليوم، يعمل الجدل الإنساني (الديالكتيك البشري) من دون أن يكون موصولًا أو مؤسَّسًا على أي خطاب أخلاقي.
في السابق، كانت العمليات التي تُحوِّل الإنسان إلى مجرّد أداة أو كائن موضوعي، تشعر – ولو على المستوى الخطابي – بضرورة بناء خطاب أخلاقي. وكانت المطالب القانونية والسياسية دائمًا تستشعر الحاجة إلى الاستناد إلى مرجعيات أخلاقية.
أما اليوم، فهناك مطالب قانونية وسياسية بلاستيكية تتجول بلا مرجعيات أخلاقية واضحة. لا أدري إن كنتم تلاحظون، لكن حتى إيقاع الشعارات بات مشوّهًا وميتًا. لم يعد هناك رابط حقيقي بين "الحق" و"أن تكون محقًا".
فأن تكون محقًا لم يعد يشير إلى "الحق" ذاته، بل أصبح وسيلة لتحقيق مكاسب آنية على حساب الآخرين، يُستخدم كأداة تموضع تكتيكية للإطاحة بالخصوم. ورغم أن توصيل الفعل السياسي بخطاب أخلاقي لا يكفي وحده لإنقاذه، كما أشرت سابقًا، إلا أنه على الأقل يُبقي فرصة تأسيس تجربة لاحقة على أرض صلبة.
أليست مأساة سيزيف تنبع من هنا؟ رغم علمه المسبق بأن الصخرة ستتدحرج معه إلى الأسفل، إلا أن إصراره البطولي على دفعها كل صباح هو ما يمنحه وجوده وقيمته.
أما اليوم، فلا يوجد في الأفعال السياسية أي سردية بطولية من هذا النوع. حلّ التطهير العاطفي (الكاثارسيس) محلّ السرد الملحمي.
والكاثارسيس دائمًا ما يكون حاضرًا بدرجة ما في الفعل السياسي، لكن اليوم، بات يستولي على الفعل نفسه، بل أصبح هو الفعل ذاته.
أما الفعل الخلّاق، فيبدو لي وكأنه محاولات يائسة وارتجالية لكسر ضغط داخلي يستبطنه الفعل ويجعله عقيمًا من الأساس. ومع ذلك، لا شيء من هذا كلّه يعادل في أهميته تلك العاطفة الطاغية التي تدفع الفعل بعيدًا عن كل تأصيل أو تأسيس.
هذه العاطفة هي: الكراهية. اليوم، لم تكن الإنسانية يومًا في تاريخها بهذا القدر من الخضوع لهذا الشعور. الكراهية ليست فقط إلى جانبنا أو داخلنا؛ إنها مهيمنة علينا. هل تدركون ذلك؟ إنها هي من تُديرنا...
صحيح أن الكراهية تنشأ من الاعتراض على العمليات التي تُشيّئ الإنسان، وتنمو داخل شرنقة من الأخلاق. وهناك من الأسباب ما يكفي ويزيد لتبرير الكراهية... لكن ما إن تخرج هذه العاطفة من شرنقتها الأخلاقية، حتى تنفصل عنها. وتنمو بسرعة فائقة، لأنها تتغذى من نفسها ومن نقيضها في آنٍ معًا. وكلما كبرت، زاد بعدها عن الأخلاق.
ما فعله ترامب، هو ضمان لما سيفعله لاحقًا. لقد أوصلته إلى موقعه هذا نخبة الطبقة الوسطى من "الهيبيين" و"اليوبيين"،
التي تحوّلت فردانيتها النخبوية إلى فرض قسري وكراهية للعامّة. أما ترامب وأتباعه، فدافعهم الكراهية تجاه هذا النخبوية ذاتها.
نحن الآن وسط دوامة مدهشة ومُفقدة للعقل من الكراهية. هل ترون أي مخرج من هذا المشهد؟...
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس