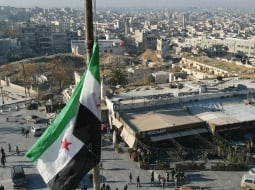د. طالب عبد الجبار الدّغيم - خاص ترك برس
عبّر المفكر إدوارد سعيد عن دور المثقف بوصفه «منفيّاً دائماً، ومضادّاً للسلطة، ومُعبّراً عن المقموعين»، واستقرت الفكرة الجوهرية لرسالة المثقف حول التزامٍ أخلاقي ومعرفي حيال الحقيقة؛ فدوره يتمثل في ممارسة مقاومة معرفية، والاضطلاع بمسؤولية ضميرٍ يُعيد وصل ما انقطع بين الإنسان وقضاياه.
إلّا أنّ هذه الفرضية، في السياق السوري، تهاوت تحت ضغط الطائفة والمصلحة والاصطفاف، فتحوّل عددٌ من المثقفين إلى وكلاء سرديات لا تُعبّر عن الضمير الجمعي بقدر ما تحاكي سيكولوجيا الخوف أو نزعات الهيمنة. ولم يعد السؤال عن موقع المثقف من الصراع، بل عن طبيعة العلاقة التي تربطه بمنظومة العنف: هل هو شاهد؟ أم محرّض؟ أم مبرّر؟
لقد وضع الانفجار الداخلي السوري، بطابعه الاجتماعي والطائفي والسياسي، المثقفَ أمام لحظة اختبار كاشفة. وهو اختبار يمكن فهمه من خلال مفهوم "الذنب الوجودي" لدى الفيلسوف الألماني كارل ياسبرز، الذي يرى أن الصمت في مواجهة الجريمة لا يُنتج حيادًا، بل يُشكّل تورطًا أخلاقيًا لا يُغتفر.
وهذه المقالة محاولةٌ تفكيكية لقراءة خيانة المثقف السوري، من منظورٍ غرامشياني يربط المثقف بالبنية، وماكيافيلياني يرصد توظيف الأخلاق في خدمة المصالح والقوة، وذلك في سبيل إعادة الاعتبار لدور المثقف العضوي، بوصفه شاهداً على الحقيقة، وفاعلًا في إنتاج المعنى، ومؤمنًا بوظيفته المعرفية في مقاومة الباطل.
المثقف السوري واغتراب الضمير
يُقدّم المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي في كراسات السجن تصوراً بنيوياً للمثقف، يرفض فيه عزله عن البنية الطبقية والسياسية للمجتمع الذين نشأ فيه، ويصنّفه بوصفه "مثقفاً عضوياً"، فاعلًا في إعادة إنتاج النظام الرمزي، ومهيمِناً على أدوات الوعي الجماعي. وضمن هذا الإطار، لا يمكن فهم المثقف السوري الذي اصطفّ إلى جانب نظام الأسد البائد أو انخرط في الخطاب الطائفي في مرحلة ما بعد سقوطه، كحالة فردية معزولة، بل ينبغي قراءته كجزء من بنية ثقافية وظيفية، شاركت في شرعنة العنف، وإعادة تدوير آليات الهيمنة في لحظة تفكك سياسي واجتماعي عميقة.
وعلى الضفة المقابلة، تكشف ماكيافيلية بعض المثقفين عن انقطاع حادّ بين المبدأ الأخلاقي ووظيفة الخطاب؛ إذ لم تعد مقولة "الغاية تبرر الوسيلة" قاعدة سياسية، وإنما تحولت إلى إستراتيجية بلاغية تُنتج تواطؤاً ناعماً مع الانتهاك أو الخروج عن القانون، وتُخضع المعايير الإنسانية لمنطق المصلحة والتحالفات، وتبرر العنف لغايات مرحلية. ومن هنا يغدو المثقف شريكاً في بناء ما يمكن تسميته بـ"البنية التبريرية للعنف"، حيث يُختزل الإنسان إلى معطى وظيفي في معادلات الاصطفاف والنجاة، ويصبح دور الضمير التعامي أو الإنكار.
إنّ هذا التحوُّل من النقد إلى التبرير، ومن الانحياز إلى الحقيقة إلى التطبيع مع الخطأ، يُمثل انحرافاً جوهرياً عن الوظيفة التاريخية للمثقف الناقد والعضوي. فالمثقف الذي يبرّر الاستبداد والظلم، أو يصمت عن الجريمة، بحجة الواقعية أو تجنّب الفوضى، إنما يُنكر إنسانيته قبل أن يُنكر مسؤوليته الأخلاقية. ولذا، يُحذّر القرآن الكريم من التورط في كتمان الشهادة، بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ (البقرة: 283)، فالمسألة تتعدى الموقف السياسي إلى الامتحان الأخلاقي، والذي يمس جوهر إنسانية الإنسان، ودوره في إنتاج الوعي ومساءلته، وقد نبّه المفكر مالك بن نبي إلى خطورة هذا الانفصال بين الثقافة والضمير، حين قال: "القضية ليست في أن نكون مثقفين، بل في أن يكون لنا ضمير ثقافي".
وفي هذا السياق، تحوّل بعض المثقفين السوريين إلى "فنيّي سرديات"، يوظفون أدوات التفكيك لتعويم الألم، أو تطويعه ضمن سردية النظام الأسدي أو خطاب الهيمنة والاستقطاب من الأطراف المتنازعة في المرحلة الانتقالية. فيما لجأ آخرون إلى التذرع بـ"الحياد الإيجابي" أو "الاستقلال المهني"، متجاهلين أن الصمت، كما يصفه الروائي والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر: "هو في ذاته موقف سياسي، وأن الحياد في لحظة المجازر لا يعني إلا الانخراط الرمزي في الجريمة".
إن أخطر أشكال انحراف المثقف هو التورط اللا واعي أو التحيز المضمر، حين يتخفّى خلف خطاب المواربة والتجريد أو يرتدي ثوب الحكمة والتوازن العقلاني. فما معنى أن يُنتج مثقف نصاً مطوّلاً عن "أزمة العقل التنويري" أو "أزمة الحداثة"، بينما تُرتكب مذابح في مسقط رأسه دون أن يُسجّل موقفاً عادلاً يثبت أنه مثقف الضمير الجمعي وليس فئه اجتماعية أو منطقة بعينها؟
الطائفية كنموذج فوق ثقافي: انكفاء المثقف إلى جماعته الأصلية
إذا إذا كانت الطائفية، كما يعرّفها عزمي بشارة، "مقولة هوياتية ما دون وطنية تُمارس الفعل السياسي على أساس الانتماء الأولي لا على أساس العقد الاجتماعي"، فإن تغلغلها في البنية الثقافية لا يعكس فقط أزمة الانتماء، بل يكشف عن تصدّع عميق في المشروع الوطني وانهيار مرتكزاته لصالح البنى التقليدية والولاءات ما قبل الدولة.
وقد شكّل السياق السوري المأزوم نموذجاً صارخاً لهذا الانزياح، حيث انكفأ عددٌ ملحوظ من المثقفين إلى "قبائلهم الرمزية"، سواء من خلال خطابهم الضمني، أو انحيازاتهم المضمرة، أو صمتهم الانتقائي تجاه العنف والانتهاكات الصادرة عن جماعاتهم الأصلية. وهو ما يُمثّل تخلّياً واضحاً عن دور المثقف بوصفه حاملًا لمشروع الدولة الوطنية والهوية الجامعة، وتحولاً خطيراً من فاعلٍ في إنتاج الوعي العام إلى ناطق باسم الجماعة، ومساهم مباشر في تكريس الانقسام الهوياتي.
إن انحياز المثقف إلى طائفته أو قبيلته أو جماعته المصلحية هو خيانة للرسالة الأخلاقية والإصلاحية التي يفترض أن ينهض بها، وتفريط بمنطق المواطنة لصالح منطق الولاء البدائي. وقد عبّر القرآن الكريم عن معيار الالتزام الأخلاقي الذي لا يستثني أحداً، بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (النساء: 135).
لقد برزت في المشهد السوري، ولا سيما في بعض الأقليات الطائفية أو التيارات الإيديولوجية، فئة من "المثقفين الطائفيين والإيديولوجيين المقنّعين" الذين استخدموا خطاباً مدنياً من الخارج، لكنه كان مؤسَّساً على خوف دفين من الآخر، أو على حرص مصلحي على حماية مكتسبات جماعتهم الأصلية. فبعضهم برّر استمرارية النظام الأسدي بذريعة "حماية الأقليات"، وآخرون اعتبروا انهيار الدولة خطراً على "مشروعهم الثقافي".
وبعد سقوط النظام الأسدي، أعادت أزمة الهوية الطائفية إنتاج نفسها بوضوح في أحداث الساحل السوري، وكذلك في التطورات الأخيرة في السويداء؛ حيث برزت أصوات مثقفين تتحدث عن "الخصوصية الثقافية" أو "الاستثناء التاريخي" للطائفة العلوية أو الدرزية، متجاهلة بصراحة أو عبر التورية، الانتهاكات التي رافقت هذه الأحداث. ففي الحالة الأولى، تم التغاضي عن جرائم القتل المروعة التي ارتكبتها فلول النظام بحق عناصر الأمن والمدنيين الأبرياء، وفي الحالة الثانية، تمّ تجاهل عمليات تهجير البدو السُّنة، وتورط بعض الفصائل المسلحة وفلول النظام البائد في شبكات الكبتاغون، إلى جانب استغلال الرمزية الدينية الدرزية لتبرير استقلالية القرار الأمني والإداري في السويداء خارج إطار الدولة، والارتهان لعدو يقصف المدن السورية لأجل جماعة محددة داخل سوريا.
وحين يصمت المثقف أمام هذه الانتهاكات والخيانة العلنية، اتقاءً لفقدان موقعه داخل الجماعة، بل ويتحدث علناً بلغة تُحمّل المسؤولية لطرف واحد وتبرّئ الطرف الآخر إلى حد كبير، فإنه لا يفرّط بوظيفته العضوية فحسب، بل ينقضُّ على جوهر مهمته الكونية بوصفه شاهداً على الحقيقة. وإن الانحياز العلني في لحظة تستوجب أعلى درجات النزاهة، لا يُفضي إلا إلى سقوط أخلاقي مدوٍّ، يعكس تصدع البنية القيمية لهذا المثقف، وانتهاء دوره التوعوي والتوجيهي لكل الناس.
من النقد إلى التموضع: المثقف بين سلطة السوق الثقافي والشرعنة الرمزية للعنف
في عالم ما بعد الحداثة، كما يُشير عالم الاجتماع زيجمونت باومان Zygmunt Bauman، فإن "المثقف لم يعد نبيّاً اجتماعياً، بل صار مستشاراً عند الطلب". هذا التحول من الموقع الأخلاقي إلى الوظيفة الأداتية، جعل كثيراً من المثقفين السوريين يُبدّلون مواقفهم بحسب الممول، والمنبر، والجمهور المستهدف. ولم يعد الانتماء للقيم، بل للفرصة المتاحة.
وفي مرحلة "إعادة تدوير الصراع"، جرى استيعاب شرائح واسعة من المثقفين السوريين في مشاريع دولية وورش عمل تحت عناوين مثل "السلم الأهلي" و"العيش المشترك"، دون مساءلة حقيقية لجذور العنف، أو لهياكل الإقصاء، أو لمفهوم العدالة الانتقالية. اختُزلت الثقافة إلى أداة بروباغندا ناعمة، والمثقف إلى "عامل تمكين" يخدم أجندات منظمات غير حكومية وسفارات، تبحث عن واجهات ناطقة بلغة حقوق الإنسان، ولكنها معزولة عن أي عمق نقدي أو بعد تحرري حقيقي.
وفي الفضاء الإعلامي، اِتخذ المثقف دور "الخبير المحايد"، يشرح دون أن يدين، ويُحلّل دون أن يشتبك، كمن يصف المجزرة بصيغة الجملة الاسمية. وهو ما حذّر منه بول ريكور بقوله: "الحياد المعرفي في القضايا الأخلاقية هو شكل من أشكال الشراكة الرمزية في الجريمة."
وإذا كانت الغرامشية تدعو إلى بناء "هيمنة ثقافية بديلة" من خلال تحالف المثقف العضوي مع القوى الاجتماعية المهمشة، فإن ما نراه في سوريا اليوم هو العكس تماماً: إعادة إنتاج الهيمنة لصالح رأس المال، والطائفة، وبُنى السلطة المهترئة. فالمثقف الذي يفتقر إلى شجاعة الانحياز للعدالة، يجد نفسه، عاجلًا أم آجلًا، جزءاً من ماكينة التبرير، وأداة لتجميل الواقع وإدامة بنيته القمعية.
خلاصة ...
نحتاج اليوم إلى "مثقف مقاوم" كما وصفه إدوارد سعيد، يواجه السرديات المهيمنة لا يجملها، ويتحدث من خارج المنظومة السياسية والاجتماعية لا من داخلها، وينحاز للحق والحقيقة. وهذا لا يتحقق إلا بمراجعة جذرية لأسس التشكل الثقافي والمعرفي، وبفك الارتباط بين الثقافة والسلطة، وبإحياء فلسفة الالتزام الأخلاقي وتمثيل الضمير الجمعي.
لا سبيل للخروج من الكارثة السورية دون استعادة المعنى، وإعادة الاعتبار للكرامة، وللثقافة كفعل مقاوم. فالكلمة، كما يقول الشاعر محمود درويش، "قد تنقذ من الموت"، ولكنها أيضًا قد تبرّر الموت، إن خرجت من فم مثقف فقد بوصلته، أو باع ضميره، أو قايض الحقيقة ببقائه.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس