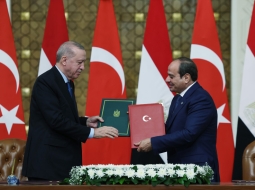ترك برس
سلّط مقال لـ سامي العريان، أستاذ الشؤون العامة ومدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية بجامعة إسطنبول صباح الدين زعيم في تركيا، الضوء على مستقبل المشروع الصهيوني، في ظل التطورات الإقليمية والعالمية ذات الصلة.
وقال العريان، في مقاله على موقع "الجزيرة نت" إن حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي أعقبت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت تهدف إلى كسر الشعب الفلسطيني من حيث فرض الاستسلام، وتفريغ غزة من أهلها، وإرهاب الضفة الغربية، وإخضاع شعب كامل من خلال النار، والخوف، والجوع. لكنها فشلت.
وأضاف: لم ينكسر الفلسطينيون. دفنوا شهداءهم، وأسعفوا جرحاهم، وتمسكوا بأرضهم وبالحقيقة الدائمة أن قضيتهم لا تطفئها حصارات ولا قصف ولا تهديد. شاهد العالم حملة شاملة من الإبادة والتدمير تبث مباشرة من كل هاتف، ومعها انكشف إفلاس نظام دولي يزعم التحضر وهو يسلح كيانا استعماريا استيطانيا يقتل الأطفال، ويستهدف براءتهم، ويجوعهم.
وفيما يلي تتمة المقال:
يضع هذا الفشل الكيان الصهيوني أمام خيار إستراتيجي طالما حاول تجاهله. لم يعد بوسعه الادعاء بأن الهيمنة تُقبل بوصفها سلاما، أو أن الفصل العنصري يُقبل بذريعة الأمن، أو أن التهجير الجماعي يُقدم كعملية إنسانية. لقد سقط القناع.
والسؤال الآن ليس هل سيغير الكيان الصهيوني مساره، بل أي مسار سيحاول سلوكه، وكيف سيسرع كل مسار بدوره نهاية المشروع الصهيوني، بوصفه نظام هيمنة وتفوق عرقي على شعب أصيل في وطنه لآلاف السنين؟
هناك أربعة سيناريوهات ترسم الأفق اليوم. كل منها يكشف التناقض الداخلي لمشروع يريد ادعاء الديمقراطية بينما ينكر الحقوق الأساسية. يريد الأرض دون أهلها، ويريد شرعية دولية دون قانون دولي. كل مسار يقود إلى الوجهة نفسها: تفكيك بنى الهيمنة والسيطرة الصهيونية؛ لاستعادة العدالة للفلسطينيين، وتحقيق سلام حقيقي للمنطقة.
السيناريو الأول: مآل الدولتين
لا يزال العالم يدعو إلى ما يسمى بحل الدولتين. كان هذا المسار السياسي يفترض أن يكون حصيلة عملية أوسلو الفاشلة منذ 1993. تصدر العواصم البيانات، وينفض الدبلوماسيون الغبار عن خرائط قديمة. العبارات مألوفة: دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية، إزالة المستوطنات غير القانونية، إيجاد ممرات آمنة بين القطاع والضفة، وإنهاء الاحتلال والحصار.
لكن الجميع يعرف أيضا لماذا يبقى هذا الهدف بعيد المنال. فالضفة الغربية مخنوقة بمئات الحواجز، والاستيلاء على الأراضي ومصادرتها مستمران، بينما كتل الاستيطان تتمدد. والأرض الفلسطينية مجزأة إلى جزر تحت الهيمنة الصهيونية من قلنديا إلى حوارة، بينما تم ضم القدس الشرقية فعلا.
لقد أمضى الكيان الصهيوني عقودا لجعل قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا، ليشير بعدها إلى سياسات فرض الأمر الواقع التي صنعها؛ ليدعي أنه لم يبقَ ما يتفاوض عليه.
ولكن، لنفترض وجود جهود دولية حقيقية لقيام دولة فلسطينية، عندها سيجبر الكيان الإسرائيلي على العودة إلى حدود ما قبل 1967 المعروفة بالخط الأخضر، فتكبح أحلام التوسع الدائم، وتنتهي أدوات الضم.
يعتقد معظم الإسرائيليين أن دولة فلسطينية ذات سيادة فعلية تمثل تحديا وجوديا للأيديولوجيا الصهيونية؛ لأنها تقرر المبدأ الجوهري: أن الفلسطينيين شعب ذو حقوق، لا كتلة بشرية يتم التحكم بها وإدارة حياتها. لن يختفي اللاجئون، فهناك أكثر من سبعة ملايين فلسطيني خارج الوطن سيواصلون المطالبة بحق العودة، كما ستبقى القدس الشرقية لأهلها.
حتى إن نجح هذا المسار- وهو أمر مستبعد جدا- فسيكون بداية نهاية الكيان الصهيوني بوصفه نظام تفوق وهيمنة؛ لأنه سوف يسلم حينها بالحقيقة التي أنكرها لأكثر من قرن: أن الفلسطينيين بشر متساوون، لا تتوقف حقوقهم عند حاجز عسكري. يدرك الكيان كل ذلك، ولهذا سوف يقاومه ويواصل عرقلته كلما أمكن ذلك.
السيناريو الثاني: دولة ديمقراطية واحدة
الأرض بين النهر والبحر هي وحدة جغرافية واحدة. يدرك الكيان الصهيوني هذه الحقيقة حين يصر على فرض سيطرته من رفح إلى رأس الناقورة، ومن يافا إلى أريحا.
فإذا أصر على أرض موحدة، وخضع للضغط العالمي ليقر نظاما سياسيا واحدا بحقوق متساوية، فلن يعود الكيان بعدها قادرا على الادعاء بأنه "دولة يهودية". يمكنه أن يكون دولة ديمقراطية، أو دولة إثنية-دينية، لكن لا يمكنه أن يكون الأمرين معا.
ولقد حسم الواقع الديمغرافي هذا الجدل. فحتى من دون احتساب فلسطينيي الخارج، يشكل الفلسطينيون اليوم أكثر من نصف السكان الذين يحكمهم الكيان في أرض فلسطين التاريخية. إن نظاما دستوريا واحدا يضمن المساواة في الحقوق المدنية والسياسية سوف ينهي الحركة الصهيونية بوصفها مشروعا استعلائيا، ويستبدلها بدولة مدنية، أو جمهورية مواطنين متساوين.
قد يكون هذا هو الأفق الأخلاقي الذي يتبناه كثيرون حول العالم اليوم، ولهذا تحديدا سيرفضه الكيان الصهيوني؛ لأنه يناقض أسس أيديولوجيته التي قام عليها.
السيناريو الثالث: ترسيخ نظام فصل عنصري دائم
وهو الخيار الذي سلكه الكيان لسنوات طويلة: ضم مزيد من الأرض؛ مسح الخط الأخضر من الناحية الفعلية مع إبقائه لزوم الدعاية، إعلان السيادة من النهر إلى البحر مع حرمان الخاضعين لسلطته من أبسط الحقوق، إبقاء غزة تحت الحصار والضفة تحت الحكم العسكري، مصادرة الأرض وخنق الفلسطينيين، شق طرق لليهود فقط وإقامة جدار الفصل العنصري، توسعة المستوطنات والبؤر ثم شرعنتها بأثر رجعي، ابتكار مصطلحات قانونية جديدة لتمويه أساطير قديمة.
فهو يدعي الأمن بينما يقصد الهيمنة، ويقول إنه مؤقت بينما يعني أنه دائم. كما يقوم بمضايقة وحصار والتنكيل بالفلسطينيين حتى ييأسوا ويستسلموا ويرحلوا.
هكذا كانت غزة قبل طوفان الأقصى، وهي حقيقة من الصعب لها أن تدوم. بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تراكمت الإدانات الأخلاقية والقانونية ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، حيث وصفت منظمتا العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، هذا الكيان بأنه نظام فصل عنصري.
كما أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر بالتدابير المؤقتة في يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار 2024، كما أصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي توقيف بحق رئيس وزراء الكيان الصهيوني ووزير حربه السابق، في مايو/أيار 2024.
قد يستعرض الكيان قوته أو يستنفر داعميه الدوليين، لكن لا يمكنه ادعاء أي سلطة أخلاقية أو الحفاظ على مصداقية سياسية. لقد تحرك المجتمع المدني العالمي بصورة حاسمة، ورفض كثيرون هذا المسار.
في كل عواصم العالم تتعالى أصوات المساجد والكنائس والنقابات والطلاب والمهنيين وقيادات المجتمع المدني رافضة التواطؤ. كما تتعاظم الضغوط على الحكومات مطالبة بحظر السلاح والتجارة، والامتثال للقانون الدولي.
وكلما حاول الكيان الإسرائيلي إبقاء أكثر من نصف السكان في فلسطين التاريخية بلا حقوق، ازداد عزلة. فالاقتصادات المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة والأسواق العالمية لا تزدهر عندما تكون أنظمتها في وضع المنبوذ، كما أن الثقافة والمعرفة لا تزدهران في الدول التي تمارس البلطجة والاستعلاء. ومع الزمن سوف تتشقق جدران الإفلات من العقاب. وعندما تسقط هذه الجدران سيتداعى وينهار الكيان الصهيوني في نهاية المطاف.
السيناريو الرابع: الترحيل الجماعي
وهذا هو الوهم القديم لفكرة "الترانسفير" بثوب عصري. يتصور الصهاينة أنه إذا عجز الكيان عن حكم شعب ما، يمكنه إزالة هذا الشعب. فهم يتحدثون عن "الانتقال الطوعي" و"الممرات الإنسانية"، فيما منطقهم الحقيقي هو التطهير العرقي.
لقد كشفت غزة الإرادة الصهيونية في محاولة فرض ذلك، ولكنها كشفت حدود هذه الإرادة. فعلى الرغم من عامين من حرب كانت أشد مشهد قتل وإبادة شهده الإقليم، لم يغادر الفلسطينيون، بل دفنوا أبناءهم وبقوا، وأصبح صمودهم مضرب مثل.
وفي الضفة الغربية مثال آخر على هذا الثبات الأسطوري. لقد تعرضت أحياء ومجتمعات وقرى لهجمات وتدمير، ولكنها عادت وبنت نفسها من جديد.
لقد أدركت دول المنطقة أن قبول نقل السكان سيشعل مجتمعاتها، لذا فهي ترفض أن تكون أدوات تهجير. العالم اليوم متصل بالكاميرات والهواتف، فلا يمكن إخفاء الجرائم كما كان من قبل.
ليس هناك مكان في العالم يمكن أن يدفع إليه ملايين الناس من دون انهيار النظام الدولي. لقد فشلت المحاولة الإسرائيلية، بدعم أميركي لامحدود، للتهجير القسري في غزة، خلال عامين فشلا ذريعا.
وبالتالي فإن أي محاولات مستقبلية لطرد الفلسطينيين قسرا من غزة أو الضفة ستسرع بانهيار شرعية الكيان الإسرائيلي، وتدفع حتى الدول المترددة إلى التحرك ضده، بل إنها ستعجل بنهايته لا أن تبطئها.
ماذا تكشف الطرق الأربعة؟
أيا يكن السيناريو، فنهاية الصهيونية السياسية هي النتيجة الحتمية. يظهر كل مسار أن الكيان الصهيوني قد بلغ حافة نهايته. فهو لا يستطيع قبول دولة فلسطينية حقيقية من دون التخلي عن حلم التوسع الدائم، ولا يستطيع قبول دولة ديمقراطية واحدة من دون إنهاء هويته كنظام تفوق عرقي وديني، ولا يستطيع إدامة الفصل العنصري من دون أن يصبح منبوذا عالميا ينزف دعما وقدرة عاما بعد عام، ولا يستطيع تحقيق الترحيل الجماعي من دون إشعال أزمة إقليمية ودولية تسرع من عزله وانهياره.
المسألة ليست بين نصر وهزيمة، بل هي بين صيغ متعددة من التراجع الإستراتيجي. لم تعد الأزمة في العالم هي "القضية الفلسطينية"، بل أصبحت "المشكلة الإسرائيلية" التي ينبغي على العالم أن يواجهها ويتحداها ويتعامل معها.
فالنظام القائم على السلب والهيمنة سيستخدم كل أداة للبقاء، بينما المطلوب هو إنهاء هذه الحلقة في الصراع عبر تفكيك البنى وإسقاط السياسات التي تمكن لهذه الهيمنة.
تفكيك البنى الصهيونية هو الهدف الإستراتيجي
التفكيك ليس شعارا، بل الإستراتيجية العظمى. عنصرها الأول هو إبقاء الناس متجذرين على أرضهم. يجب حماية الفلسطينيين في غزة، وفي الضفة والقدس، وداخل خطوط 1948، وفي مخيمات اللجوء في المنطقة، من التهجير.
وكل ذلك يتطلب استمرار وجودهم على أرضهم، ودعم مقاومتهم وصمودهم، وإنهاء الحصار والضم، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وتأمين ممرات مساعدات، وتمويل إعادة الإعمار بدون الابتزاز السياسي، على أن تدار عملية الإعمار عبر مؤسسات فلسطينية بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة والدول الصديقة، لا عبر وصاية أجنبية أو أوامر عسكرية.
الصمود والمقاومة هما المركز الأخلاقي لهذه المعركة، فبدون وجود الشعب على أرضه تصبح العدالة مجردة بلا روح ولا معنى.
والعنصر الثاني من عملية التفكيك هو بناء حركة عالمية تحدد مواطن قوة المشروع الصهيوني لتضعفه وتنهكه في كل مكان. ينبغي للحركة أن ترسم خرائط مصادر قوته من شبكات الضغط السياسي واللوبيات التي تمول أنشطته التدميرية، ومحاولات الإفلات من المحاسبة في البرلمانات؛ تدفقات رأس المال التي تمول الاستيطان والسلاح؛ تقنيات المراقبة التي تحول المدن إلى سجون مفتوحة؛ منظومات الإعلام التي تبيض الجرائم بوصفها "سرديات أمنية"؛ شراكات أكاديمية تطبع الفصل العنصري وتجعله مقبولا أو تبرره وتقدمه كابتكار؛ عقائد عسكرية تجعل العقاب الجماعي إستراتيجية؛ دروع قانونية تعطل مؤسسات الردع والعقاب.
كل إستراتيجية لاستمرار وتمدد الكيان يجب أن تقابلها إستراتيجية مضادة: فرض سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في الاستيطان والحصار؛ ربط التجارة والبحوث العلمية بالامتثال للقانون الدولي؛ فرض حظر على السلاح وإنهاء تبادل خبرات الشرطة وبرمجيات التجسس التي تمكن القمع؛ الدفاع عن الحرية الأكاديمية مع رفض الشراكات التي تلمع الفصل العنصري؛ حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ استخدام الولاية القضائية العالمية والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية لملاحقة جرائم الكيان الجسيمة؛ تعطيل الأنظمة المالية التي تقوم عليها الشراكة في الجريمة؛ وحفظ الذاكرة عبر أرشيفات شهادات الناجين من الفلسطينيين وتوثيق المجتمع الفلسطيني تحت الاحتلال، بحيث لا يمحوها أي إنكار لاحق.
يجب أن تكون هذه الحركة عابرة للحدود وشاملة. تتمحور حول الفلسطينيين لكنها تتعدى جهود الفلسطينيين وحدهم. ستحتاج هذه الحركة إلى النقابات التي تغلق الموانئ أمام شحنات السلاح، والأطباء الذين يرفضون جعل الدواء سلاحا في الحرب، والمهندسين الذين لا يوقعون عقودا لبناء القنابل والأسلحة والسجون والجدران، والفنانين الذين يحركون الضمير، والطلبة والأساتذة الذين يرفضون تحويل الجامعات إلى أدوات رقابة أو دعاية، وللجماعات الدينية والمؤسسات الثقافية التي تقول إن النصوص المقدسة والقيم الأخلاقية لا يمكن أن تستخدم كغطاء للقسوة أو لنزع الإنسانية عن الفلسطيني وضحايا الصهيونية، وللحركات العالمية التي تتضافر جهودها ضمن لغة مشتركة للعدالة والحقوق والحرية والمساواة والكرامة.
كما ستحتاج إلى اليهود المعارضين للصهيونية، الذين يرفضون الكذبة القائلة إن تحرر الفلسطينيين يهدد أمنهم، وكذلك إلى المسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات الأخرى، بل غير المتدينين من الذين يفهمون أن الخط الفاصل هو بين الحق والباطل، بين الهيمنة والحرية، بين الحياة الكريمة والعبودية، وبين واقع مستعمر ومستقبل متحرر من الاستعمار.
إن الإطار الأخلاقي لهذه الحركة واضح: الصهيونية هي أيديولوجيا عنصرية استعلائية ومشروع استعمار استيطاني إحلالي أنتج نظام فصل عنصري. الصهيونية ليست اليهودية. إن جوهر الصراع هو مع أيديولوجيا وبنى ومؤسسات شيدتها وساندتها، لا مع دين أو شعب.
كما أن معاداة اليهودية أو ما يطلق عليه في الغرب بمعاداة السامية مرفوض، شأنه شأن الإسلاموفوبيا وسائر أشكال العنصرية. فالنظام القائم على العدل وإعطاء الحقوق ينهي نظام التمييز العنصري والديني والخوف، ويستبدله ببنية سياسية تكون فيها السيادة لأهل البلد.
على المدى القريب سيحاول الكيان الصهيوني الحفاظ على اختلال توازن القوى لصالحه، حيث سيسعى إلى الإبقاء على الحصار قائما، كما سيواصل ضم الأراضي في الضفة، ويصعد الهجمات على المجتمع المدني والصحفيين، وسيسعى إلى إعادة تسويق رواية "الدفاع عن النفس" منزوعة السياق، وسيعول على إنهاك الآخر.
والمطلوب هنا هو منع هذا الانحدار من خلال الإبقاء على الكاميرات مشغولة ومشتعلة، وتحويل أوامر المحاكم إلى سياسات دولة، ومطالب الطلاب إلى سياسات جامعية، وقرارات النقابات إلى تغييرات في سلاسل التوريد، وقرارات البلديات إلى قواعد للمشتريات تمنع التعاقد مع الشركات المتورطة في حرب الإبادة، ومقالات الرأي إلى تعهدات علنية من المسؤولين المنتخبين. باختصار يجب ضمان أن يدفع الكيان الإسرائيلي ثمنا باهظا كلما حاول انتهاك أبسط معايير الإنسانية.
أما على المدى المتوسط فلا بد أن يعاد تفعيل خيارات إستراتيجية ضد الكيان الإسرائيلي من خلال الضغط السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يجب أن تنتقل سياسات بعض الدول من الأقوال إلى الأفعال، حيث يغدو تعليق عضوية الكيان الصهيوني في الأمم المتحدة مطلبا عالميا، ويصبح حظر السلاح سياسة شائعة، وتتسع العقوبات التجارية والاقتصادية الشاملة ضد الكيان، وترسم المؤسسات الثقافية والأكاديمية خطوطا أخلاقية ملزمة.
عندها سيرد الكيان بالغضب وبسياسة دعائية جديدة، وسيزعم أنه مستهدف. والجواب لا بد أن يكون واضحا: حين ترتكب دولة أو تمكن الإبادة الجماعية، وتقنن الفصل العنصري، فإنها تسقط حقها في أن تعامل كدولة طبيعية.
السابع من أكتوبر/ تشرين الأول: تسريع نهاية الصهيونية
عرت غزة الأوهام. لقد أظهرت عمق شجاعة الفلسطينيين وصمودهم وثباتهم، وكلفة التواطؤ والتخاذل، وضعف كيان لا يجد بدّا من قصف المستشفيات، وتجويع العائلات؛ ليحافظ على هيمنته ليشعر بأمان مخادع.
ليست السيناريوهات الأربعة طريقا لانتصار المشروع الصهيوني، بل مراحل على طريق أفوله. المهمة هي في التعجيل بهذه النهاية ببناء حركة عالمية توازي حجم الجريمة واتساع الأمل: إبقاء الناس على أرضهم، إعادة بناء الحياة المحطمة، إنهاء الحصار، تحرير الأسرى، ملاحقة الآمرين والمرتكبين للجرائم، ومحاصرة بنى الهيمنة والدمار حتى اقتلاعها.
العدالة ليست منحة، بل القيمة العليا، والحرية ليست شعارا، بل الهدف الجوهري، والاستقلال ليس خيارا، بل واجبا، وتقرير المصير ليس وهما، بل الغاية القصوى، والعودة ليست حلما، بل حقا. حين نعتبر هذه الحقائق منبر هدايتنا، يصبح الطريق الذي بدا مستحيلا هو الطريق الوحيد المعقول. لقد حمل شعب فلسطين هذه الحقيقة من نكبة إلى أخرى، وها هو العالم أخيرا يبدأ الآن في الإصغاء ورؤية الحقيقة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!