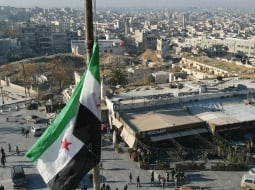محمد مختار الشنقيطي - الجزيرة
تتزاحم الرهانات الكبرى في الانتخابات التركية الحالية، من صراعات الهوية، إلى مطامح المكانة، ومن المعضلة الاقتصادية، إلى التموقع الإستراتيجي. ويمكن القول من دون مبالغة إن هذه الانتخابات حرب سياسية ناعمة لتحقيق الاستقلال الثاني، بعد 100 عام من الحرب العسكرية الخشنة في سبيل الاستقلال الأول. ولئن كانت حرب الاستقلال الأولى قد أنقذت الأناضول من التمزيق طبقا لأهواء المستعمرين في اتفاقية "سيفر" الآثمة عام 1920، وحققت رحيل الاحتلال العسكري المباشر، فإنها تركت ملفات مفتوحة، منها استقلال القرار الإستراتيجي، وصيانة الهوية الثقافية، ومكانة تركيا في العالم.
وتبدو الانتخابات الحالية كمفترق طرق حاسم، يشبه مفترق الطرق الذي مرت به بلاد الأناضول منذ 100 عام، بل لعل مفترق الطرق اليوم أشد تعقيدا وتركيبا. وسيضطر الشعب التركي للاختيار يوم غد الأحد 14 مايو/أيار بين خيارين متناقضين تماما:
أحدهما هو الاستمرار في المسيرة التي يقودها الرئيس أردوغان بحزم وثبات، وهي انبعاث الهوية الإسلامية واحترام الذات، واتساع مساحة الحرية يوما بعد يوم، واستقلال القرار الإستراتيجي، وبناء المناعة الذاتية، بما يضمن لتركيا مساحة لائقة بين الأمم، وصعودا مطردا إلى مصاف القوى العالمية.
وثانيهما مسار مغاير تتبناه المعارضة، وهو الرِّدة السياسية والثقافية، والعودة إلى عهد التبعية والهوان، والفساد المزمن، والركود الاقتصادي، والتسوُّل على موائد الغرب، والحكومات الائتلافية الهشة، والسياسات التلفيقية القاصرة، ووهَن العزائم السياسية، وتراجع المكانة الإقليمية والدولية.
ويمكن اختزال الرهانات الكبرى التي يتعين على الشعب التركي حسْمها في الانتخابات الحالية في 4 أمور: رهان الهوية المنشطرة هل هي إسلامية أم غربية؟ ورهان النظام السياسي الأليق هل هو الرئاسي أم البرلماني؟ ورهان التموقع الإستراتيجي هل يكون بالانفتاح أم بالانكفاء؟ ورهان التعافي الاقتصادي هل يكون بالإنتاج أم بالاستهلاك؟
الرهان الأول: الهوية المنشطرة
إن أول الرهانات الكبرى في الانتخابات التركية الحالية هو التغلب على انشطار الهوية الذي عانت منه تركيا خلال تاريخها الحديث. فقد فشلت النخبة التركية التي قادت حرب الاستقلال (1918-1923) فشلا ذريعا في التعاطي الإيجابي مع مسألة الهوية، رغم مكاسبها العسكرية والسياسية العظيمة. فكان من مفارقات تلك النخبة جمْعُها بين الانتصار العسكري في حرب الاستقلال والهزيمة الثقافية بعد الاستقلال. ولعل تحويل جامع آيا صوفيا إلى متحف -تقرُّبا من الغرب المسيحي- مجرد مثال على ذلك، حيث استطاع رجلُ دينٍ وعالم آثار أميركي هو توماس ويتيمور (1971-1950) إقناع مصطفى كمال أتاتورك عام 1931 بكل سهولة ويسر بهذا الأمر، حفاظا على الرموز الدينية المسيحية في المبنى، على ما في ذلك من ضرب عرض الحائط بنحو 500 عام من التاريخ الإسلامي، وبواقع الحال الدال أن أهل هذه المدينة العريقة قد أصبحوا مسلمين منذ قرون، بغضّ النظر عما مر عليهم من أديان قبل ذلك.
يروي الباحث في التاريخ المسيحي ريتشارد وينتسون في كتابه "تاريخ آيا صوفيا" Winston, Hagia Sophia: A History عن ويتيمور قوله: "كانت آيا صوفيا مسجدا في اليوم الذي تحدثتُ فيه معه (أي مع أتاتورك)، وفي صبيحة اليوم التالي زرتُ المسجد فوجدتُ إعلانا على بابه بخط يد أتاتورك نفسه يقول: (إن المتحف مغلق للصيانة)!" وقد جاء هذا القرار المجحف بالهوية الإسلامية لتركيا ضمن منظور تغريبي يتحكَّم فيه مركًّب النقص والإحساس بالدونية الثقافية، والدعوة إلى الأخذ بكل ما هو غربيّ "بوُرُوده وأشواكه"، حسب تعبير كاتب تركي معاصر لتلك الفترة.
وقد حقق الرئيس أردوغان للشعب التركي شيئا من المصالحة مع ذاته وتاريخه وهويته، بعد قطيعة قهرية أليمة حذَّر منها شاعر النيل حافظ إبراهيم في رثائه لمسجد آيا صوفيا بعد تحويله متحفا، فقال:
أيا صوفيا حان التفرُّق فاذكُري عهودَ كرامٍ فيكِ صَلَّـوْا وسَلَّمُوا
ولا تنكـري عهدَ المـآذن إنه على الله من عهد النواقيس أكرمُ
وواضح من لغة الخطاب السياسي السائد في هذه الانتخابات أن صراع الهوية لا يزال على أشدِّه في تركيا، وأن على الشعب التركي أن يسير مع ما يقتضيه احترامه لذاته وتاريخه العريق في الإسلام، بدل الانجرار إلى الهويات المستعارة الزائفة.
الرهان الثاني: النظام السياسي
ومن الرهانات الكبرى في الانتخابات التركية الحالية طبيعة النظام السياسي الأليق بتركيا، والأوفق مع تطورها السياسي وبنيتها الاجتماعية: هل هو النظام الرئاسي الحالي الذي انتقلت إليه منذ عام 2017، أم هو النظام البرلماني الذي كان سائدا فيها منذ عقود. ومن المعروف في العلوم السياسية والقانون الدستوري أن لكل من النظامين الرئاسي والبرلماني جوانبه الإيجابية والسلبية، وأن النظام البرلماني بما يقود إليه من تشرذم وضَعْف في مصدر صناعة القرار، ومن تحكُّمٍ للأقلية في الأغلبية، لا يناسب المجتمعات التي تعيش حالة انتقال من الحكم العسكري إلى الحكم الديمقراطي، كما هو حال تركيا، بل يقود إلى الشلل في المؤسسات الحكومية، وطغيان المزايدات والمهاترات على الساحة السياسية، على حساب الإنجاز والبناء والاهتمام بمصالح الشعب، ويفتح الباب لتدخل الجيش في السياسة، كلما انسدت أبواب التوافق بين الخصوم السياسيين المتشاكسين، ولا شيء يقتل التطور السياسي الطبيعي كتدخل الجيش في السياسة.
فالنظام البرلماني قد يناسب بعض الديمقراطيات العتيقة التي أصبحت مؤسساتها صلبة ومستقرة، وهي لا تعاني من تشرذم داخلي ولا من تدخل خارجي، مثل بعض الدول الغربية. علما بأن أكبر ديمقراطية غربية، وهي الولايات المتحدة، يحكمها نظام رئاسي، لا نظام برلماني، منذ أكثر من 200 عام. أما تركيا فلا يناسبها اليوم سوى النظام الرئاسي -بغضّ النظر عن شخص الرئيس- حتى تصْلُب مؤسساتها الديمقراطية وتترسَّخ، وتصبح عصيَّة على أي اختراق أو تخريب.
ويجب ألا ننسى في هذا السياق أن الديمقراطية التركية كانت مهدَّدة بانقلاب عسكري مدعوم من الخارج منذ سنوات قليلة، أقصد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، ولولا شجاعة الرئيس أردوغان ومبادرته، وتضحية الشعب التركي وبسالته، لضاع كل شيء في تلك المغامرة الدموية الأثيمة. فليست العودة إلى النظام البرلماني في صالح تركيا وتطورها السياسي في الأمد القريب على الأقل. كل هذا طبعا إذا افترضنا أن السيد كمال كليجدار أوغلو -في حالة فوزه المُستبْعَد- سيقبل بالتحول إلى النظام البرلماني الذي سيجرِّده من صلاحياته، ويجعله أسيرا للأحزاب الصغيرة، وهذا أمر غير وارد أصلا. فصخَبُ بعض أحزاب المعارضة التركية حول ضرورة العودة إلى النظام البرلماني لا يعدو أن يكون مزايدة ومشاغبة سياسية على الرئيس أردوغان، وسعيا من بعض القوى الدولية إلى إضعاف تركيا، وحرمانها من وحدة القرار الإستراتيجي في لحظة التحول الحالية.
إن الدول التي تمر بمرحلة انتقال تكون في مسيس الحاجة إلى قيادة قوية ومستقرة، وتركيا من الدول التي لا تزال تعيش مرحلة انتقال سياسي، فهي تحاول منذ عقدين أن تتخلص من مواريث الانقلابات والتدخل العسكري في السياسة، وأن تتحرر من النفوذ الأجنبي في المعادلة السياسية الداخلية، وأن تستكمل نهضتها الجديدة الكبرى التي بدأتها مع بداية القرن الـ21. ونظرا لحالة الانتقال السياسي هذه، وظروف الطوارئ الناشئة عن مأساة الزلزال الأخير، فإن الرئيس أردوغان الذي قاد نهضة تركيا الحالية لا يزال لديه الكثير مما يقدمه، والشعب التركي بحاسته السياسية العميقة، التي تضرب جذورها في تاريخ إمبراطوري عريق، يدرك تماما أن الرئيس أردوغان مؤهَّل أكثر من غيره لاستكمال حالة البناء، وإيصال السفينة إلى برِّ الأمان.
أما الأحزاب المعارضة في الطاولة السداسية، فليس في برنامجها بديل سياسي جديّ. وحاصل خطابها مجرد نقد سلبي بارد، ومناكفة خطابية سطحية. كما أن هذه الأحزاب ليست منسجمة فيما بينها، بل هي أشبه ما تكون بكتلة ملفَّقة لغايات انتخابية ظرفية. وليس من الوارد أن تتفق هذه الأحزاب -المتناقضة أيديولوجيا- على برنامج سياسي أو اقتصادي واحد، بل سيكون قادتها شركاء متشاكسين في السلطة، مما يقود إلى شلل الحكومة، وفشل مشاريع البناء. وقد جرب الشعب التركي من قبل الحكومات الائتلافية في التسعينيات، فكانت دائما هشة البناء، سيئة الأداء.
الرهان الثالث: المكانة الدولية
أما الرهان الثالث الذي يتعين حسمه في الانتخابات التركية الحالية فهو مكانة تركيا وتحالفاتها الإقليمية والدولية. فتركيا اليوم مصنَّفة لدى علماء الجغرافيا السياسية والدراسات الإستراتيجية ضمن القوى الإقليمية الصاعدة. لكن مكانتها وإمكانها يؤهلانها لأكثر من ذلك، وهو التحول إلى قوة عالمية في المستقبل. والنخبة الحاكمة في تركيا اليوم بقيادة الرئيس أردوغان واعية بهذا الإمكان، ساعية إلى تحقيقه. لكن الأمر يحتاج إلى جملة شروط، أهمها تعضيد الجبهة الداخلية، واستمرار البناء دون قطيعة. وأمامه عدد من العوائق، أهمها أن القوى السائدة لا تمنح القوة الصاعدة مساحة في النظام الدولي بسهولة، حرصا على الاستئثار بالهيمنة. وتحتاج تركيا -كقوة صاعدة- أن تشق طريقها ببصيرة وحذر وصبر إستراتيجي، لكي تحقق ما تطمح إليه دون اصطدام بالقوى الدولية السائدة.
وفي هذا السياق سيتعين على الشعب التركي أن يختار بين المعارضة التركية التي لا تزال مُسْتأسِرة لعهود التبعية الإستراتيجية للغرب، ومدمنة على دبلوماسية التسوَّل والتوسُّل التي اعتادتها القيادات الضعيفة المهزوزة في دول أخرى، وكأنما تخاف من تبعات استقلال القرار الإستراتيجي ومسؤولياته، وبين قيادة الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية التي تتسم بالشجاعة، والثقة بالذات، والخيارات المفتوحة، والمرونة التكتيكية، وتوثيق روابط تركيا بمحيطها التاريخي في العالم العربي وآسيا الوسطى والبلقان، والسعي إلى بناء مساحات مشتركة مع كل القوى الدولية لمصلحة تركيا، ورفْض الوصاية على القرار الإستراتيجي التركي.
إن القيادة ذات الحاسة الإستراتيجية نعمة عظيمة في أي بلد يحظى بها. وليس من ريب في أن قيادة الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية برهنت خلال أكثر من 20 عاما على أنها تتمتع بحاسة إستراتيجية مرهَفة، حيث درجت على التحرك الذكي بما يحقق مصالح الدولة والشعب، ضمن حدود الزمان والمكان والإمكان، مع قدر عظيم من التوازن المبدِع والحسِّ العملي الذي يحقق التوازن العسير بين المبدئية والواقعية، ويتعامل مع تناقضات القوى الدولية ببصيرة سياسية.
فالخيار المنطقي أمام تركيا اليوم هو الاستمرار في المسار التصاعدي الذي بدأته منذ عقدين، فهذا هو المنسجم مع موقعها الجغرافي والتاريخي، وهو الذي يليق بها مكانا ومكانة. وإذا كانت بعض القوى الدولية استطاعت في الماضي وضع تركيا في موقع المفعول به، وتحويلها مجرد سدٍّ أصمَّ بينها وبين شعوب الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، فلا يليق بالشعب التركي أن يقبل العودة إلى تلك الحقبة القاتمة من تاريخه المعاصر، بعد أن حققت تركيا في ظل الرئيس أردوغان استقلال قرارها الإستراتيجي، وصارت فاعلا جدِّيا يحسب له الجميع ألف حساب، وأصبحت كل القوى الدولية مضطرة للتعامل معها تعامل الأنداد.
الرهان الرابع: التعافي الاقتصادي
رغم وضعنا لهذا الرهان في ختام اللائحة لاعتبارات النظر الإستراتيجي، فإنه لا يقل عنها أهمية من الناحية الانتخابية على الأقل، إن لم يكن يتصدَّرها كلها. لقد دخل الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية من باب الاقتصاد، وكان الإنجاز المطَّرد للرئيس وللحزب في هذا المضمار هو الرافعة الكبرى لصعودهما المستمر. لكن السنوات الأخيرة شهدت مصاعب اقتصادية جمَّة في تركيا. ولا يمكن تحميل الأزمة للقيادة السياسية التركية الحالية، فهي أزمة مركَّبة ذات أبعاد دولية، ليس أقلها تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي. لكن ذلك قد لا يعفي القيادة التركية في نظر قطاع من الناخبين الذين لا يهمهم في السياسة سوى ثمراتها الاقتصادية المباشرة.
وقد اختار الرئيس أردوغان الطريق الصعب الذي يقود إلى النمو الاقتصادي الصلب. وهو طريق الاستثمار الإنتاجي، وتطوير البنية التحية، وحرية السوق، لضمان نمو أقوى وأبقى، رغم وطأته على الشعب في المدى القريب. وجاء ذلك مخالفا لما درجت عليه دول أخرى في الإقليم، ومنها دول عربية مجاورة لتركيا، أدمنت على سياسات الدعم والاستهلاك والاستدانة، فانتهت إلى إفلاس الخزينة، وتوقُّف الإنتاج، وهروب الاستثمار، وإفقار الشعب من حيث أُريدَ إسعافُه. وتكشف الأمر في النهاية عن سياسات إلهاء ظرفية، تراكمت بعدها أزمات اقتصادية واجتماعية، تكاد تعصف بتلك الدول اليوم وتفجِّرها من الداخل.
وقد استغل الإعلام الغربي المعادي بعض المصاعب الاقتصادية في تركيا، لتجييش الشعب ضد الرئيس وحزبه، رغم كل ما وفرته القيادة الحالية من ضمان اجتماعي لتخفيف الأعباء عن عموم الشعب، دون إخلال بالمعادلات الاقتصادية السليمة. لكن لحسن حظ الرئيس أردوغان وبُعْد نظره أنه ركز على حل المعضلة الكبرى التي استنزفت خزينة الدولة التركية المعاصرة منذ مولدها قبل 100 عام، وهي مشكلة استيراد الطاقة الذي تنفق عليه تركيا جزءا وافرا من ثروتها.
وقد أدى هذا الجهد الصبور من الرئيس وحكومته إلى اكتشاف الغاز التركي في البحر الأسود، والاستثمار فيه حتى وصل إلى البيوت في أرجاء تركيا منذ أسابيع. كما تكشَّف الأمر عن اكتشاف حقول نفط في مواطن أخرى من تركيا. وهذه سابقة لها ما بعدها في تاريخ الاقتصاد التركي. فلأول مرة لن تكون الميزانية التركية مرهقة باستيراد الطاقة، بل ستوفر ثروة ضخمة جراء وجود الطاقة المحلية، فضلا عمَّا يفتحه ذلك من آفاق التطور الصناعي، بعيدا عن الاعتماد على الآخرين.
وخلاصة الأمر أن الرهانات الأربعة تشير كلها إلى أن المسيرة التي اختطَّها الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية لتركيا هي التي ستفرض نفسها على الناخب التركي الواعي. ولا عجب في ذلك، فشتَّان ما بين من يريد تركيا رأساً في الشرق، ومن يريدها ذيلاً في الغرب.
وشتاَّن ما بين اليزِيديْن في النَّدَى يزيدِ بن عمروٍ والأغرِّ ابن حازمِ
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس