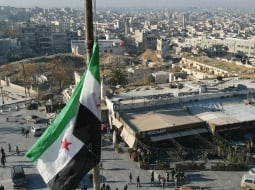سليمان سيفي أوغون - يني شفق
توفي سري ثريا أوندر. رحمَه الله. أشعر بالحزن... كانت بيني وبينه معرفة سابقة. منذ سنوات، كنت ضيفًا في برنامج "حدود المكسيك" الذي كان يتابعه جمهور كبير، وكان يقدّمه أحبّتي طارق طوفان، وإسماعيل كيليتش أصلان، وصلاح الدين يوسف. كان هؤلاء الثلاثة يُقدّمون هذا البرنامج الناجح كثلاثي لفترة طويلة، ثم انضم إليهم لاحقًا سري ثريا.
لن أطيل في السرد؛ فقد كان لدى سري ثريا كاريزما فريدة تجذب الناس إليه وتُكسبه مودّتهم من أول لقاء. وكان من عناصر هذه الكاريزما: ابتسامته الدائمة المليئة بالاحترام والمودّة، ونبرة صوته، وذكرياته، وملاحظاته الحادة، وقصائده التي كان يقرأها، والنُكت التي يرويها، وحديثه الشيّق الذي كان يأسرك.
وقد أثّر بي التأثير ذاته. في تلك الفترة، علمتُ أنه يُدرّس أيضًا مادة السينما في الجامعة التي كنت أعمل بها. التقيت به وتحادثنا مطولًا. لم تكن مواضيع حديثنا يومًا سياسية، بل كنا نتناول القضايا الثقافية والاجتماعية أكثر. وكانت هذه الأحاديث متّزنة جدًا. فقد كان سري ثريا يُجيد الإصغاء كما يُجيد الكلام.
لاحقًا، اتّجه السيد سري إلى السياسة. وبرأيي الشخصي، لم يكن ذلك قرارًا موفقًا. لو بقي رجلًا من رجالات الثقافة، وتقدّم في مجال السينما، لكان ذلك أفضل بكثير. طبعًا، هذا رأيي الشخصي، وأحترم من يرى خلاف ذلك.
أتذكّر أننا التقينا في فعالية أُقيمت لإحياء ذكرى هرانت دينك، وفي تلك المناسبة الحزينة، لا أنسى النكات التي أطلقها سري ثريا دون أن يُفسد أجواء اللقاء، لكنها كانت كافية لإضحاك الجميع دون أن تجرح أحدًا.
أما آخر لقاء لنا، فكان في شارع الاستقلال، حيث تعانقنا وتحدثنا وقوفًا لبعض الوقت. ثم افترقت طرقنا... ولم نلتقِ بعدها. هكذا كان قدره...
أضفى سري ثريا، بشخصيّته، طابعًا مميّزًا على البرلمان التركي. فقد كان يعرف كيف يُؤثّر حتى في أولئك الذين كانوا الأكثر غضبًا من أفكاره ومواقفه، ويتمكّن من كسبهم من الداخل. وخلال فترة علاجه، وضع الجميع خلافاتهم الفكرية معه جانبًا، وتوجّهوا بالدعاء له. وهذا في الحقيقة وضع غريب بعض الشيء.
أشعر أننا، في حياتنا اليومية، نعيش غالبًا صراعات ظاهرية سطحية. فنقوم بكبت مشاعرنا الحقيقية تجاه أولئك الذين نغضب منهم، أو نعارضهم، أو حتى نصطدم معهم. ولكن، لسبب ما، تظهر تلك المشاعر المخفية حين تمرّ بنا مواقف درامية، فتتحطّم القشور وتنكشف الأعماق. وقد شهدنا هذا الأمر آخر مرة بعد اغتيال هرانت دينك. وها هو المشهد ذاته يتكرّر الآن مع وفاة سري ثريا.
في جنازة هرانت دينك، كان الشعار السائد "كلّنا هرانت"، وهو شعار لم يُفرض أو يُختلق لاحقًا، بل كان تعبيرًا صادقًا ونابعًا من الأعماق عن مشاعر مكبوتة أُطلِق لها العنان. لقد عبّر هذا الشعار عن إحساس الجميع، بطريقة أو بأخرى، بأنهم يرون شيئًا من أنفسهم في هرانت.
فباستثناء المتعصّبين، تعاطف جمهور واسع من الناس الذين خالفوا أفكار هرانت، لكنهم ظلّوا يحتفظون بقدر من التعقّل، مع ذلك الشعار بدرجات متفاوتة. وقد تكرّر الأمر نفسه مع سري ثريا؛ فقد نُسيت كلّ الخلافات، بل وحتى النقاط التي كانت سببًا في الصدام، ووجد الجميع أنفسهم متّحدين في ابتسامته الصادقة، وقد اجتمعوا على مشاعر واحدة.
تبدو لي ثقافة الطبقة الوسطى في هذا البلد وكأنها مليئة بالمراوغة والتناقض. ففي هذه البلاد، تعيش غالبية كبيرة من الناس تجارب متنوّعة من الطبقة الوسطى، من هذه الجهة أو تلك. وغالبًا ما تتركّز هذه التجربة لدى الطبقات الوسطى الدنيا.
ومع أن هناك تحسّنًا في مستويات الاستهلاك، إلا أن ذلك لا ينعكس فورًا على الثقافة. فيتجسّد هذا الخلل في القشور. فثقافة الاستهلاك وفّرت للناس فرصة أن يصبحوا مستهلكين، لكنّها لم تُرشدهم إلى كيفية بناء ثقافتهم إلى جانب الاستهلاك وبشكل متوازن.
ولهذا، نجد لدى الإنسان الاستهلاكي أنواعًا عديدة من التفاخر الفجّ، والسلوك المتحدّي، والانفلات، وعبادة الذات (النرجسية)، وأشكالًا شتّى من الميل إلى الموت (النيكروفيلية). فهذه القشور ما هي إلا مؤشّر على حالة من عدم الهضم الثقافي.
ونرى انعكاسات هذا بوضوح شديد في الساحة السياسية أيضًا. ويجب أن أقول إنّ قضية "المحلية والوطنية" بعد 15 تموز، والتي أتبنّاها بدوري، لها صلة وثيقة جدًا بهذا الواقع الاجتماعي.
فإذا لم يُعمل على تصفية هذه القشور الثقافية، فلن يكون بالإمكان إحقاق المعنى الحقيقي لا للمحلية ولا للوطنية. وإذا لم تُناقش هذه القشور ولم يتم تجاوزها، فإنّ المحلية والوطنية أيضًا ستتحوّلان إلى قشرة جافة تموت مع الزمن.
شخصيات مثل سري ثريا، التي بات عددها نادرًا جدًا، تدفعني إلى التفكير العميق في هذا المعنى بالذات.
قد يخرج كثيرون للتشكيك في "وطنيّته"، لكن لا أحد يمكنه الاعتراض على "محليّته". فقد كان السيّد سرّي، بمعنى الكلمة، إنسانًا محليًا أصيلًا. لم تُغيّره التقلّبات الهائلة التي مرّ بها في حياته، الممتدّة من ولاية أديامان إلى المدن الكبرى. انخرط في أنماط الحياة الجديدة، لكنه لم ينجرف معها قط. كان ينفذ إلى عمق كل شيء، ويتكيّف معه دون أن يتخلّى عن ذاته. (وقد رأيت هذا النوع من الأصالة أيضًا عند الفنان الراحل نجدت ياشار، أحد أعظم عازفي آلة الطنبور في عصرنا الحديث).
لقد نجح في ذلك لا من خلال التخلّي عن ملابسه القديمة وارتداء أخرى جديدة، بل من خلال التمسّك بما يرتديه، وإعادة تفصيله بما يتناسب مع الظروف الجديدة. وهذه، في جوهرها، هي الممارسة الحقيقية للمحلية. والعنصر الذي يُضفي على هذه المحلية التوازن والسلاسة هو عالم الذوق الذي يجعل من البهجة محورًا له. وهذا بالضبط ما كان موجودًا في السيد "سرّي ثريا". خاض أعظم معاركه دون أن يتراجع، لكنه لم يجرح أحدًا. حتى أولئك الذين كان في صراع معهم، عرف كيف يكسبهم في النهاية.
لقد رحل جسده عن هذه الدنيا، وترك خلفه مرآة. والناس اليوم ينظرون في هذه المرآة ليروا أنفسهم، يرون قشورهم.
الطبقة الوسطى ذات الذهنية البرجوازية، التي انفصلت منذ زمن بعيد عن هذه الأرض بثقافتها المستعارة وتغرّبت عنها، ستنظر إلى السيّد سرّي وتُخفي في أعماقها حسرات.
سيدرك هؤلاء كم أصبحوا غرباء عن النُكت التي كان يرويها والتي تمزج بين الحكمة والطرافة، وعن القصائد، والأغاني الشعبية التي كان يرددها. وسيرون بوضوح ما فقدوه.
وبالمثل، من المتوقع أن ترى الطبقة الوسطى الجديدة، التي انخرطت حديثًا في الحياة الحضرية وتحمل ردود فعل محافظة حيّة لكن بثقافة هشّة، مدى جمودها وثقلها في هذه المرآة أيضًا. لكن، بصراحة، لست متفائلًا كثيرًا. فالناس – بدلًا من أن يروا في سرّي ثريا ثقلهم الثقافي – سيرون فيه فرص التعويض عنه.
قضية "المحلية والوطنية"، التي أصبحت شعار "تركيا الجديدة"، يجب التعامل معها بعناية فائقة. من وجهة نظري، تأتي المحلية دائمًا قبل الوطنية. ويجب ألّا ننسى ذلك.
فالوطنية التي لا تستند إلى محلية راسخة ستتحوّل إلى قشرة فارغة؛ وستنحرف لتأخذ شكل التطرّف المافيوي الذي يضع العنف في المركز. ومن العبث أن نحاول مناقشة الوطنية خارج إطار محلية مشبعة بالذوق والبهجة وقد تمّ تهذيبها واستيعابها بعمق.
لقد مرّ من هذه الدنيا شخص يُدعى سرّي ثريا…
نسأل الله أن يتغمّده بواسع رحمته، ويجعل مثواه في أعلى عليين.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس