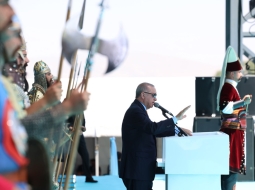د. إندر كوركماز - مجلة كريتيك باكيش الفكرية
جمعية الاتحاد والترقي والإسلامية (2)
يُجمع العديد من المراقبين على أنّ تجربة طرابلس الغرب شكّلت لحظة فارقة في مسيرة جمعية الاتحاد والترقي، إذ رأى شيخ الإسلام جمال الدين أفندي أنها غيّرت مسار الجمعية، بينما أكد المؤرخ العسكري الأمريكي ويليام هنري بيهلر أنّ هذا التغيير لم يقتصر على الاتحاديين وحدهم، بل انعكس أيضاً على العرب هناك. فقد كان بعض العرب الراديكاليين متحفظين تجاه الدولة العثمانية، لكن وصول الضباط الاتحاديين وإحياؤهم لفكرة وحدة الإسلام (اتحاد الإسلام) دفعهم إلى إعادة النظر في مواقفهم، فأظهروا ولاءً للعثمانيين وشاركوا في القتال ضد الإيطاليين.
والحق أنّ ما جرى لم يكن مجرد تبدل في الولاءات، بل لقاءً إنسانياً وثقافياً بين ضباط عثمانيين جاؤوا من البقاع البعيدة، ومعظمهم من الفرع الروملي للجمعية، وبين سكان محليين لم يعرفوا الدولة عن قرب من قبل. وهو لقاء أتاح للطرفين أن يتعارفا ويتفهّما ويجدوا أرضية مشتركة.
هذا التلاقي اكتسب قيمة أكبر عندما تزامن مع السياسات المركزية الصارمة التي تبنّتها الدولة عقب إعلان المشروطية الثانية. فالتعميم الذي فرض كتابة الأحكام القضائية بالتركية بدل العربية في المناطق العربية، مثّل نموذجاً لسياسة مركزية ولّدت امتعاضاً واسعاً في صفوف العرب والألبان. فالدولة العثمانية كانت إمبراطورية مترامية الأطراف، لكنّ إسطنبول حاولت فرض “العثمانية” كما تراها هي، دون أي مراعاة لخصوصيات الأطراف. وقد رأت البيروقراطيةُ المركزيةُ أنّ سكان الأطراف هم “بدو وجب تذويبهم ودمجهم في العثمانية”، بينما نظر الزعماء المحليون إلى المركز بوصفه قوة تسعى لتقويض تقاليدهم. وهنا جاءت تجربة الاتحاديين في طرابلس الغرب لتخفّف من هذه الفجوة، إذ أوجدت مساحة للتعارف والاندماج، وأظهرت أن الإسلام قادر على أن يكون قاعدة جامعة بين المركز والأطراف.
ولم يكن هذا مجرد خطاب، بل ممارسة عملية جسّدها أنور باشا وضباطه الشباب. فقد حرصوا عند وصولهم إلى طرابلس على التعامل مع السكان المحليين بندّية واحترام، فلم يتدخلوا في دينهم أو لغتهم أو أزيائهم أو عاداتهم، بل احترموها. وفي الوقت نفسه، حافظوا على ثقافتهم العثمانية الخاصة، لكن من دون تعالٍ. وبذلك فقد خلق هذا المناخ علاقة ثقة وصداقة مع الأهالي، والتي انعكست في تعاون وثيق مع قادة محليين بارزين مثل أحمد الشريف السنوسي وسليمان الباروني وعمر المختار. ولشدّة اندماج الأهالي مع أنور بك، ساروا خلفه في القتال حتى الموت، وأمدّوه بالمال والمؤن، وقدموا له أشكالاً مختلفة من الدعم.
غير أنّ هذه اللحظة الواعدة اصطدمت سريعاً بسياسات الحكومة العثمانية آنذاك. فمع اندلاع حرب البلقان الأولى، أقدمت حكومة أحمد مختار باشا – التي هيمنت عليها العناصر المناوئة للاتحاديين – على عقد صلح سريع مع إيطاليا رغم اعتراضات أهالي طرابلس. لكن المفارقة أنّ هذا القرار لم يقطع صلة الأهالي بالدولة العثمانية، بل عزّز شعورهم بالارتباط بها، خصوصاً بعد أن منحت الدولة في 17 أكتوبر 1912 طرابلس الغرب وبرقة حكماً ذاتياً، قبل يوم واحد فقط من توقيع معاهدة أوشي. وكان ذلك اعترافاً عملياً بأن المركزية العثمانية لم تعد ممكنة، وأن الحكم الذاتي أصبح صيغة لا مفر منها لتنظيم علاقة المركز بالأطراف. من هنا بدأ مفهوم المُخْتارية (الحكم الذاتي) يأخذ مكانه في سياسة الدولة تجاه الأقاليم البعيدة.
إنّ هذا التحول لم يقتصر على شمال إفريقيا فحسب، بل وصل أيضاً إلى اليمن. فقد عُرف الإمام يحيى حميد الدين بمقاومته المستمرة للعثمانيين وتمرده عليهم. لكنّ توقيع اتفاق دعّان عام 1911 مع حكومة إبراهيم حقي باشا التي سيطر عليها الاتحاديون، أنهى الصراع الطويل عبر منح الزيديين بعض السلطات المحلية. وهكذا أدرك الاتحاديون أنّ المركزية القاسية غير قابلة للتطبيق في اليمن، فاختاروا نظاماً لامركزياً قائماً على الرابطة الإسلامية. وبفضل ذلك، بقي الإمام يحيى مخلصاً للعثمانيين حتى بعد الإغراءات البريطانية، واستمر هذا الارتباط حتى عام 1924.
إنّ هذه الأمثلة تدلّ على أنّ سياسة الاتحاد والترقي لم تكن مجرد براغماتية عابرة. ففي الداخل، عمل الاتحاديون على بناء الدولة وفق نموذج حديث يشبه الدولة–الأمة، لكنهم ملأوا مفهوم الأمة بالمضمون الإسلامي. ولعل أبرز ما يجسّد ذلك هو قانون حقوق العائلةالصادر عام 1917 في عهد طلعت باشا، والذي نظّم شؤون الأسرة على أساس الفقه المالكي، بعيداً عن الرؤية الغربية لمسائل مثل الميراث وتعدد الزوجات. لقد أعاد هذا القانون الاعتبار للشريعة في صيغة مقننة داخل مؤسسات الدولة الحديثة.
أما في التعليم، فقد سعى الاتحاديون إلى دمج المدارس الشرعية مع النظام التعليمي الرسمي، معترفِين بشهاداتها ومؤسسين مدارس جديدة مثل مدرسة الأئمة والخطباءومدرسة القضاة. وقد كانت تلك البذور الأولى لما يُعرف اليوم بمدارس إمام خطيب التركية. وهكذا، استعاد التعليم الإسلامي مكانته في نظام التعليم الحديث، واكتسب صفة الاستمرارية والاعتراف.
ويتأكد هذا البعد الإسلامي أيضاً من خلال اختيار الكوادر. فقد شغل إسلاميون بارزون مناصب حساسة في الدولة، مثل سعيد حليم باشا الذي كان أطول من تولى منصب الصدارة العظمى ورئاسة الحزب. كما ضمّت الحكومات والبرلمان عدداً كبيراً من الشخصيات ذات الهوية الإسلامية، في حين ظل رموز القومية التركية البارزين خارج دوائر القرار. فحتى ضياء كوك ألب، وهو أهم منظّري القومية التركية داخل الاتحاد والترقي، لم يرَ القومية إلا متداخلة مع الإسلام، فرفض الدعوة للتخلي عن الأبجدية العربية، معتبراً الإسلام جزءاً لا ينفصل عن الهوية التركية.
ولم تقتصر الإسلامية على المؤسسات، بل انتشرت في الحياة اليومية. فقد فرض أنور باشا تعليمات بزيادة طول العباءة النسائية إلى الكعبين، ومنع اختلاط الرجال والنساء في الحدائق، ورفع رواتب أئمة الوحدات العسكرية فوق رواتب الملازمين. كما حرص على زيارة الأماكن المقدسة وإبداء التبجيل لها، وصام في رمضان في ظروف صعبة ممثلاً الجيش بأكمله. كل ذلك كان تجسيداً عملياً لرغبة الاتحاد والترقي في إضفاء طابع إسلامي على تفاصيل الحياة العامة.
إنّ استعراض هذه التجارب بين 1913 و1918 يوضح أنّ إسلامية الاتحاد والترقي لم تكن مناورة سياسية عابرة، بل توجهاً راسخاً انعكس في القانون والتعليم والدبلوماسية والحياة اليومية. فقد أدرك الاتحاديون أنّ المركزية الصارمة لا تصلح لإدارة إمبراطورية شاسعة متعددة الشعوب، وأن الإسلام هو القادر على أن يشكل القاعدة الجامعة. ومن هنا جاءت سياساتهم في طرابلس واليمن، التي أبقت تلك الأقاليم مرتبطة بالدولة، ودفعت الكثير من العرب في سوريا والعراق للوقوف إلى جانب العثمانيين خلال الحرب الكبرى. أما ما عُرف بـ“الثورة العربية” فكان محدود التأثير مقارنة بما أشيع. وهكذا، فإن الإسلام السياسي الذي انتهجته جمعية الاتحاد والترقي لم يتوقف بانتهاء الحرب العالمية الأولى، بل امتد ليشكّل أحد منابع الإلهام في حركة الكفاح الوطني لاحقاً.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!