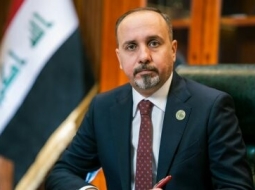سليمان سيفي أوغون - يني شفق
حصل دارون عجم أوغلو أخيرًا على جائزة نوبل. قرأت كتابه "لماذا تسقط الأمم" بدقة، ولا يمكنني القول إنني أوافق على أطروحاته بالكامل. أرى أن العلاقة التي بناها بين المؤسساتية والكفاءة الاقتصادية تحمل قدرًا من المبالغة. لا شك أن المؤسساتية تُعد عنصرًا مهمًا لتحقيق الكفاءة الاقتصادية، لكنها ليست الشرط الوحيد أو الكافي. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن المؤسساتية تلعب دورًا أكبر في السياسة مقارنة بالاقتصاد، وهذا ما تسلط عليه الأحداث الأخيرة في سوريا الضوء بوضوح.
المملكة المتحدة تقدم مثالًا حيًا على هذا المفهوم. هناك العديد من التقارير التي تؤكد ضعف الاقتصاد البريطاني. ومع ذلك، يمكننا ملاحظة أن المؤسسات والنخب البريطانية لم تعد بالقوة التي كانت عليها في الماضي. ورغم هذا التراجع النسبي، يتضح الآن أن المملكة المتحدة لم تصل إلى مرحلة الانهيار الكامل. العقيدة البريطانية تعمل حاليًا بدقة تضاهي الساعة السويسرية. فالإمبريالية البريطانية، التي سيطرت على العالم واستغلته لقرون، لا تزال تحتفظ بقدراتها وتراكماتها كاملة. في الواقع، أصبحت أكثر اقتناعًا من أي وقت مضى بأن العقل البريطاني يقود السياسات العالمية. وفي التقسيم الوظيفي بين الكتلة الأنجلوأمريكية، تتولى بريطانيا مهمة التخطيط، بينما تتكفل الولايات المتحدة بالتنفيذ.
في إطار هذه العقيدة، قطعت المملكة المتحدة علاقاتها مع الصين منذ فترة طويلة. وكانت الخطوة الأولى في "العقيدة البريطانية الكبرى" هي انسحابها من الاتحاد الأوروبي عبر "بريكست". بعد ذلك، لعبت دورًا في تخريب العلاقات التي كانت قائمة بين الاتحاد الأوروبي – وخاصة ألمانيا – وأوراسيا. عملية تخريب خط أنابيب "نورد ستريم" تعد إحدى أبرز الإشارات على ذلك. اندلاع الحرب بين أوكرانيا وروسيا جاء ليخدم هذا الهدف بالتحديد.
تتضح ثلاثة محاور رئيسية لهذه العقيدة:
إجبار أوروبا على الاعتماد في المستقبل القريب على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط، وخاصة شرق البحر الأبيض المتوسط، بدلًا من روسيا.
إخراج إيران من المعادلة باعتبارها أحد المصادر الرئيسية للطاقة التي تعتمد عليها الصين.
بناء رابط استراتيجي بين الهند – التي يراد لها أن تحل محل الصين – والشرق الأوسط عبر إسرائيل.
بهذا الشكل، تتبلور معالم العقيدة البريطانية الكبرى التي تعمل على إعادة تشكيل النظام العالمي وفق مصالحها.
بدأ مشروع زعزعة استقرار الشرق الأوسط كخطة مدروسة منذ زمن بعيد. كان الهدف الأول القضاء على أي تهديد قريب لإسرائيل، بغض النظر عن نوعه أو شكله. جرى إسقاط أنظمة البعث واحدة تلو الأخرى، بدءًا من العراق وصولًا إلى ليبيا. وفي المناطق ذات الأغلبية السُّنية، تم تقديم حركة الإخوان المسلمين كبديل يحمل تصورات ديمقراطية، رغم كل عيوبها ونواقصها. لكن سرعان ما أُحبطت هذه الطاقة التي أُطلقت، وتم قمعها بشكل منهجي. كان الانقلاب في مصر، ثم تطورات تونس، أبرز الأمثلة الدرامية على ذلك.
ارتكبت تركيا في هذا السياق أحد أكبر أخطائها الاستراتيجية. على الأرجح، أقنعت عبر إملاءات أنجلو-أمريكية بأن الربيع العربي يمثل فرصة تاريخية لها. لكنها وجدت نفسها في نهاية المطاف عالقة في فراغ سياسي كبير. وصلت هذه الأزمة إلى ذروتها في سوريا. ففي عام 2012، كان سقوط نظام الأسد يبدو أمرًا وشيكًا. ومع ذلك، تم السماح لإيران وروسيا بالتدخل، مما أدى إلى تجميد الوضع هناك. ومع انقلاب السيسي في مصر، فقدت تركيا نفوذها في مصر، ووجدت نفسها معزولة أيضًا في الملف السوري.
أما إيران، فقد تم توجيهها نحو الشرق الأوسط عبر تحفيز طموحاتها التاريخية. أُتيح لها المجال عمدًا لتوسيع نفوذها في العراق وسوريا ولبنان واليمن. علاوة على ذلك، جرى دفعها تدريجيًا لتتولى دور الراعي لقضية فلسطين.
وسط هذه التعقيدات، كثفت القوى الأنجلو-أمريكية العميقة جهودها لإعداد البنية التحتية لممرات الطاقة. واستخدمت ورقتين استراتيجيتين بالتناوب. أولًا، افتُعل صراع بين تنظيم داعش وتنظيم بي كي كي الإرهابي، كان هذا الصراع مُدارًا بعناية. تم الإيهام بهزيمة داعش، لكنه انسحب من مناطق واسعة لصالح بي كي كي، بينما تراجع نحو صحاري سوريا العميقة وإلى إدلب تحديدًا.
في النهاية، أُلقيت مسؤولية إدارة هذا الوضع – نتيجة للظروف – على عاتق تركيا التي عانت بالفعل من ضغوط ديموغرافية هائلة بسبب الأزمة، لتجد نفسها تتحمل عبء حماية واستيعاب نتائج هذه السياسات الدولية.
بالنسبة للعقلية الأنجلوأمريكية، كان تأسيس "كردستان حرة" أو "ذاتية الحكم" بمثابة الحلم المثالي. وقد تم إدراج هذا المشروع ضمن خطة بدأت بتسليم عبد الله أوجلان إلى تركيا. تم دفع تنظيم بي كي كي الإرهابي إلى خارج الحدود التركية، حيث تمركز في العراق/قنديل، وترك ليواجه حالة من الجمود. أما في سوريا، فقد تم إنشاء هيكل مختلف تمامًا تحت اسم تنظيم واي بي جي الإرهابي. (وهنا، تكرر القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" التأكيد على الفارق بين بي كي كي وتنظيم واي بي جي الإرهابي، رغم أن الأمر ليس أكثر من تلاعب بالكلمات).
مع ذلك، لم تجرِ الأمور كما هو متوقع. تدخلت تركيا وشكلت علاقات قوية مع بارزاني. في المقابل، ارتكب تنظيم بي كي كي الإرهابي المتمركز في قنديل خطأً استراتيجيًا بالتقرب من إيران. هذا التقارب عمّق الخلاف بين قنديل، الذي أصبح أقرب إلى إيران والحركات الشيعية، وبين أربيل، التي كانت تفضل الابتعاد عن النفوذ الإيراني. وفضلت أربيل البقاء قريبة من أنقرة، بينما لم تسفر جهود الوساطة التي قادها طالباني عن أي نتائج ملموسة.
حادثة إسقاط الطائرة الروسية كانت تهدف إلى تعميق عزلة تركيا، التي كانت تعيش بالفعل حالة من الفراغ السياسي. هذه التطورات وقعت بين عامي 2015 و2016. في تلك الأثناء، جرى التخطيط لمحاولة انقلاب في تركيا. إلا أن أنقرة أظهرت صلابة وقوة وتمكنت من إحباطه، لينتهي بالفشل الذريع للمخططين. وبعد استبعادها من العالم الأنجلوسكسوني، اتخذت تركيا خطوة جريئة لتجاوز عزلتها عبر تحسين علاقاتها مع روسيا وإيران. كانت تلك الأيام صعبة ومرهقة للغاية، لكن عملية أستانا نجحت في تهدئة التوتر في سوريا، ولو مؤقتًا. ومع ذلك، حالت المواقف المتعالية لكل من روسيا وإيران دون تحويل هذه العملية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
حرب روسيا وأوكرانيا جاءت على خلفية هذا المشهد. أصبحت روسيا مرهقة بشكل كبير، ورغم أنها استطاعت مواجهة التحديات بدعم من علاقاتها الوثيقة مع الهند والصين، إلا أنها لم تتمكن من تفادي الوقوع في فخ محكم. وجدت روسيا نفسها في لعبة سياسية أشبه بلعبة البوكر، حيث واجهت كتلة أنجلوأمريكية ترفع الرهانات بهدوء وثبات.
كانت روسيا تحاول المناورة عبر الخداع (بلوف)، لكن الطرف الأنجلوأمريكي كان يواصل الرد بـ"رأينا" ويزيد الرهانات.
يتبع..
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مواضيع أخرى للكاتب
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس