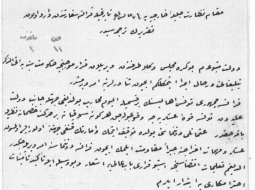د. مصطفى الستيتي - خاص ترك برس
كانت إسطنبول العثمانية رائعة ومليئة بالأشياء المثيرة الأمر الذي شد انتباه الشّرق والغرب. في الحقيقة كانت هناك مدن أخرى تعجّ مثلها بالسكان، مثل إيران وخاصة مدينة أصفهان، ودلهي في الهند المسلمة، لكنّ ثراء إسطنبول وفنها المعماري الأصيل ومكتباتها هي التي كانت تسحَر القلوب وتجعل الرِّحال تُشدّ إليها من كل مكان. وكانت قوافل الجمال تنقل الكُتب القديمة إلى المدينة بصورة دائمة ما جعل مكتباتها تفيض بالكتب.
حتى سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 م كان النّاس يُطلقون على إسطنبول أسماء كثيرة وبلغات مختلفة نظرا لغناها وثرائها، ومن بين هذه الأسماء؛ دار السّعادة، دار السّيادة، الباب العالي، مقر الخلافة، مقر السّلطنة وبوابة النّعيم وغيرها. وفي الواقع إن أسماء اسطنبول كثيرة جدّا. وفي اللّغات السّلافية يُطلق عليها اسم تسارغراد، بمعنى المدينة التي يعيش فيها السّلطان. والطّريف أنّ لوحة مواعيد الرّحلات في قاعة الانتظار في مطار صُوفيا لا تزال تشير إلى إسطنبول باسم تسارغراد.
وبالرغم من التّشويه الكبير الذي طال هذه المدينة وطال حكامها وأهلها المسلمين من قبل الكثير من المؤرخين والمستشرقين فإن بعض الكتاب الأوروبيين لم يستطع أن يخفي إعجابه الشديد بهذه المدينة واحترامه لحضارة المسلمين فيها، وما يتميّزون به من تسامح ورفق بالإنسان والحيوان. ومن بين من بهرته هذه المدينة وتحدث عنها بكل إنصاف الرّحالةِ والأديب الفرنسي الشهير "جيرار دي نرفال" (Gérard de Nerval) الذي سجَّل بموضوعيّة في مذكراته، مشاهداته عن الإنسان العثماني ومدينة إسطنبول. وعلى الرغم من أن مؤلفات هذا الأديب - الذي عاش في القرن التاسع عشر - في الشّعر والرّواية والمسرح، بقيت تُقرأ طيلة 135 عامًا، فإنه اشتهر بين الناس كواحد من أكثر الرحالة سياحةً في عصره.
وملاحظاته التي سجّلها في رحلاته تقدّم لنا اليوم معلومات موثوقة عن حياة العثمانيين وإسطنبول في القرن التّاسع عشر. وأول ملمح استرعى انتباه الكاتب تمثّل في الأخوة والتعايش في مجتمع ينتمي أفراده إلى شعوب وأديان وثقافات مختلفة. وتحدث في مذكراته عن هذا الملمح بهذه العبارات: "إسطنبول مدينة عجيبة، يعيش فيها جنبًا إلى جنب شعوبٌ أربعةٌ في غير كرهٍ بينهم ولا أحقاد، فالتّسامح الذي يبديه هؤلاء من الأتراك والأرمن واليهود والروم فيما بينهم، لا نستطيع أن نراه عندنا بين من ينتمون إلى ولايات وأحزاب مختلفة". ومن الأشياء التي شدّت انتبه هذا الأديب تواضع السّلطان، واختلاف ما رأته عيناه عمّا هو منتشر في بلاده من الصّورة الخيالية التي تتسم بالسّطوة والمهابة التي تثير الذّعر. فقد حضر الكاتب مراسم تحية يوم الجمعة والتي يحضرها من يشاء، فيمرّ السّلطان أمام الناس ويلقون عليه السلام والتحيّة، يقول واصفا هذا المشهد:
"شاهدتُ مرور السلطان في عربة متواضعة تتقدم في الطريق الهابط إلى الميناء، كان عليه معطفٌ مُزَرَّر حتى العُنق... والأمر الوحيد الذي يميّز السّلطان في لباسه عن بقية النّاس هو النيشان الإمبراطوري المرصَّع بالألماس على طربوشه".
وعن اهتمام العثمانيين بالحيوان والرفق به ينقل لنا الكاتب الرّحالة صورة تتدفّق منها رقّة المشاعر تجاه الحيوان الضّعيف فما بالك بالإنسان. ومن المعروف أن الدّولة العثمانية أسّست أوقافا لرعاية الكلاب والقطط الضالة حتى لا تبقى فريسة للجوع والبرد والحرّ، كما أن هندسة بناء المساجد كانت تراعى فيها وضع أماكن خاصة في القباب وفي الجدران حتى تتمكن العصافير من بناء أعشاشها، وسميت هذه الأماكن الصّغيرة بـ"بيوت العاصير". وما نقله "جيرار دي نرفال" أثناء مُشاهداته في اسطنبول يؤكد المدى الحضاري الذي بلغته هذه الدولة، يقول: "كانَ في المْرج بضعُ مئات من الكلاب تنتظر وقد بدأ صبرها ينفد، وبينما هم كذلك إذ ظهر العساكر يحملون قدورًا كبيرة معلَّقة على أكتافهم بالعِصيّ. فبدأت الكلاب تتقافز في الهواء عندما رأتهم وكأنّها تكاد تطلق صيحات الفرح، وما أنْ وُضعت القدور على الأرض حتى اندفعتْ مسرعة نحوها. وكان العساكر يحاولون تفريقها إلى مجموعات بالعِصيّ التي يحملونها. قال لي إيطالي كان هناك: يُطبخ هنا طعام خاصّ بالكلاب! إنّ هذه الحيوانات لم تكن سيّئة الحظ أبدًا. وفي إسطنبول أقيمت الأحواض قُرب المساجد وصنابير المياه لتنتفع منها الحيوانات إضافة إلى الجمعيّات التي تهتم بحمايتها".
ويَعترف الكاتب بأنّ الأوروبيين يسيئون فهم معتقدات المسلمين وأخلاقهم، بل ويبالغون كثيرا في نقدها، ويعتبرون أن طُرق العيش عندهم هي المقياس لما هو صحيح وما هو خطأ، وهو نفسه كان يحمل بعض هذه الأفكار والأحكام المسبقة. وعند مقارنته بين الحياة في مجتمعه والحياة في المجتمع العثماني يسجل الملاحظات التالية: "أرى أنه من الخطأ بمكان، اتهام المسلمين باحتقار النّساء، واتهامهم بالسّخافة في بعض عاداتهم دون أن نُدرك الاختلاف الكبير في المعتقدات والعادات بيننا وبينهم، فليس من الصحيح أن نصدر أحكامنا في حقهم انطلاقًا من أخلاقنا. فإذا أخذنا في الحسبان علاقة المسلم بزوجته وغيرته في موضوع "العِرْض"، فإننا عندئذ ندرك الافتراءات السّفيهة التي اختلقها كتَّابنا في القرن الثامن عشر".
ومن الأشياء التي رسخت في ذهن الكاتب ولم يرها قط في بيئته أجواء السعادة التي كانت منتشرة يوم العيد، وكيف أنه لا فرق بين مسلم وغير مسلم في المجتمع، فالجميع يشاركون فيه، بل إن بيوت المسلمين كانت مفتوحة على مصراعيها، فيدخل من يشاء لا فرق في ذلك بين غني وفقير. وقد سجل الرّحالة هذه المشاهد في ذهول قائلا: "يدخل المرء إلى أي بيت يريد، ويجلس على المائدة فيُستقبَل بحفاوة. فالبيوت كلها مفتوحة الأبواب على مصاريعها، يحاول الجميع تقديم ما يستطيعون من الضيافة، ويحاولون إضفاء السرور على الضيوف مهما كانت أديانهم أو أعراقهم أو مقاماتهم الاجتماعية، لا فرق في ذلك بين غني أو فقير". فهل كان يمكن للقادمين إلى الدّولة العثمانية الذين يقفون في حيرة وإعجاب أمام هذه السلوكيات الراقية، أن يظلوا بمنأى عن التأثر بهذا الدين الذي كان سببًا لمثل هذا البناء الأخلاقي العظيم؟!
إنّ الحقد الذي ميز بعض المستشرقين هو الذي أشاع عن المسلمين عامّة وعن العثمانيين بصورة خاصة صورة بعيدة تماما عن الحقيقة، وبدل هذا المشهد النّاصع الذي نقله هذا الرّحالة المُحايد من واقع مشاهداته، نجد صورًا قاتمةً عن الأتراك العثمانيّين لا تمتّ إلى الحقيقة بأيّة صلة. ومما يؤسف له أنّ الباحثين المسلمين والعرب بشكل خاص قصّروا أيّما تقصير في الردّ على حملات التّشويه التي طالت تاريخنا، والأدهى من ذلك أن كتابات هؤلاء المستشرقين المُغرضين المُشبعة بالكراهيّة والتحريض أصبحت مراجع علميّة في كثير من جامعاتنا العربيّة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
مقالات الكتاب المنشورة تعبر عن رأي كاتبها، ولا تعبر بالضرورة عن رأي ترك برس